بسم الله الرحمن الرحيم
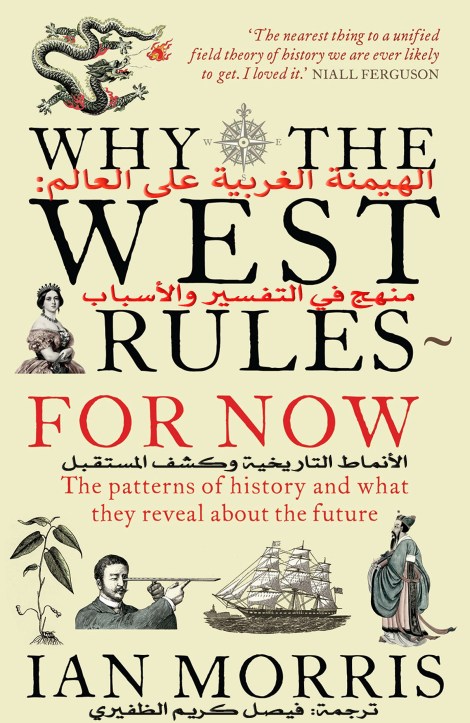
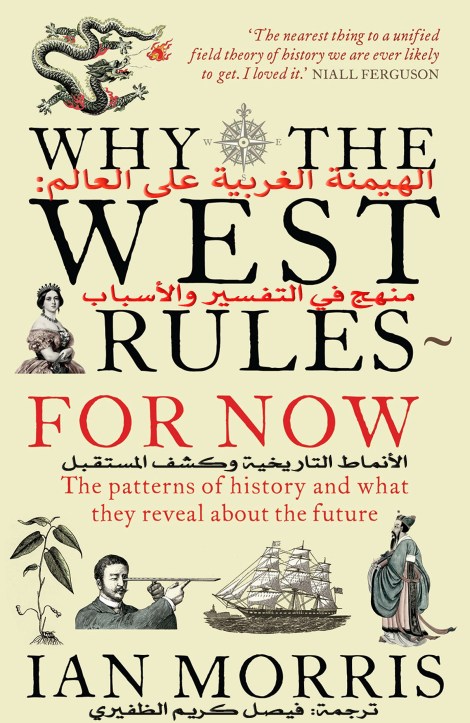
الهيمنة الغربية على العالم:
منهج في التفسير والأسباب
منهج في التفسير والأسباب
الأنماط التاريخية وكشف المستقبل
تأليف: بروفيسور إيان موريس
ترجمة: فيصل كريم الظفيري
توطئة: هذه ترجمة لمقدمة كتاب:
Why The West Rules-For Now:
The Patterns Of History and What They Reveal About the Future.
لمؤلفه البروفيسور إيان موريس الذي نشر الكتاب أواخر سنة 2010، وحاز على تقديرات هامة وتصدر لفترة تصنيف أهم مبيعات الكتب الصادرة في الولايات المتحدة. وقد أحدث الكتاب آراء متباينة وردود أفعال أكاديمية متعددة، إذ عده كثير تتمة للمنهج الذي التزم فيه جاريد دايموند في كتابه الهام “مدافع وجراثيم وفولاذ” الصادر سنة 2005، حيث الرؤية الشمولية للتاريخ وحركاته البشرية الكبرى والقراءة الشاملة للتاريخ كقصة بشرية متكاملة منذ التطور البشري تقريبا، أو على أقل تقدير الخمسة عشر ألف سنة المنصرمة.
“التغيير يسببه أناس كسالى وجشعون وخائفون، وهم يبحثون عن طرق سهلة وأكثر ربحا وأمنا لإنجاز الأشياء. ونادرا ما يكونون على دراية بما يقومون به“. يبدأ البروفيسور إيان موريس التمهيد لأفكاره بهذه “النظرية الموريسية” كما وصفها بفقرة ساخرة من المقدمة، لكنه يبني عليها فعلا عمله الجاد في تأسيس معيار ومقياس شمولي يجتهد فيه بقراءة الأسباب التي جعلت الغرب يتبوأ مركز الريادة والهيمنة على العالم في جميع المجالات. على أننا يجب أن ندرك بدقة ما يعنيه موريس بمفهوم “الغرب” هنا. فهو يقصد بإطار عام ما يطلق عليه خط موفيوس الذي ينسب إلى عالم الآثار الأمريكي هالام موفيوس ونشر فكرتها سنة 1948، حيث يقسّم الغالم القديم بين غرب وشرق بهذا الشكل

مشكلة المصطلح التاريخي: تبرز هنا معضلة ترجمة المصطلحات التاريخية. فالعقبة التي تقف بين المترجم الجاد وإضفاء الطابع العلمي والأكاديمي السليم لترجمته تتجلى في وضع المصطلحات الصحيحة والمعمول بها في هذا المجال العلمي. فللمترجم أن يبحر في سفينة ترجمته حيثما شاء، غير أن إبحاره لن يحوز على معنى وقيمة وهو بلا بوصلة تحدد وجهته ومسلكه. ولعل هذا الشأن يذهب بنا إلى الثنائية التي لا أعتقد أن أحدا وصل إلى حل لها حتى الآن:
- هل يجب أن يترجم لمجال علمي بعينه المتخصص فيه حصرا لأنه قادر على تطبيق مصطلحاته وتوظيفها في النص توظيفا سليما؟
- أو أن المترجم المتخصص هو الأولى بنقل النص العلمي أيًا كان مجاله ومهما اختلف، بحكم إلمامه بعملية الترجمة وما تتطلبه من شروط وقواعد وأحكام؟
وهذه المسألة تنطبق بطبيعة الحال على علم التاريخ. وأرى أن أفضل حل لهذه المعضلة هو العمل المشترك بين الطرفين، والأسلوب الأمثل لذلك أن المترجم هو المعني بصياغة عموم النص وإيصال أفكاره للقارئ بإجادة وسلاسة، في حين أن المختص والخبير في حقله معني بضبط المصطلحات وتعديل الصياغة بما يصب في تأطير النص تأطيرا علميا واصطلاحيا دقيقا ومنضبطا، لكي تصلح الترجمة برمتها كعمل قابل للدراسة والتوثيق. ومن هذا المنطلق، أشير إلى أن هذه الترجمة تحتاج إلى الشق الثاني من المعادلة، لاسيما في ضبط بعض مصطلحات النص. وأبرز هذه المصطلحات الواردة في النص عبارة
Locking in
التي تعددت مفاهيمها بدرجات متقاربة كما يشرح موقع القاموس الحر الإنجليزي. غير أن استقراري آل إلى مفهوم “الحتمية” إذ إن المؤلف يعالج بالشرح مدرسة تاريخية ترى أن هيمنة الغرب تجلت في الوصف الذي تطرحه العبارة الإنجليزية. لكنني آثرت في اللحظة الأخيرة أن أردف ترجمة العبارة بكلمة تدخل ضمن هذه الدلالة، وهي كلمة “الديمومة” التي لا تنفصل كذلك عن صلب الفكرة. هنا يأتي دور الخبير المختص في التاريخ ليحسم هذه التعددية في الاصطلاح. ومن نافلة القول، أن هذا النص المترجم خاضع للنقد والتجريح والتنقيح لكل من هو مؤهل لاقتراح الإضافة أو الحذف أو التعديل الصياغي والأسلوبي واللغوي والاصطلاحي حتى تعم الفائدة لكل قارئ.
أنوّه إلى محافظتي على جميع الحواشي والهوامش التي وضعها المؤلف، وسردتها في آخر النص لمن يريد الحصول على هذه المراجع والمصادر بالغة الأهمية. كما أشير إلى بعض الحواشي التي أضفتها شرحا لبعض العبارات والمفردات التي اقتضت ذلك، وقوّستها بالإشارة إلى أنها من المترجم.
تنويه: هذه الترجمة ملكية فكرية لمدونة المترجم فيصل كريم الظفيري، ويرجى عدم الانتفاع منها ماديا بأي شكل من الأشكال، وعند اقتباسها كليا أو جزئيا الرجاء الإشارة بوضوح إلى اسمي المترجمين.
——————-
كلمة شكر وعرفان: أوجهها إلى الدكتور عبد الحميد مظهر الذي أشار لأهمية الكتاب (وإلى كتب أخرى كثيرة) وشجعني بخوض غمار الترجمات النصية الموسعة التي تعمل على نشر المعرفة والتنوير بإتجاهه الصحيح. وكان قد لفت انتباهي إلى الكتاب منذ منتصف عام 2014، فترجمت ما يقرب من 8 صفحات من المقدمة على أمل أن تتولى إحدى دور النشر العربية عملية الترجمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما يبدو. فتوقفت عن ترجمة ما تبقى من المقدمة طوال هذه الفترة، فقررت قبل شهر رمضان الفائت (1438) أن أنهي ترجمتها ليستفيد القارئ على الأقل من ملخص أفكار الكتاب، الذي لا أعلم إن تصدى أحد لترجمته أم لا. وهو ما حدث بُعيد الأسبوع الأول من ذلك الشهر، غير أن التأخر بمراجعة الترجمة وتنقيحها حال دون نشرها في منتصف رمضان أو في أواخره على الأقل.وأوجه شكرا جزيلا إلى الأستاذ منتظر السوادي لمراجعته الصفحات الثمانية الأولى من ترجمة هذه المقدمة التي تحتوي على 30 صفحة تقريبا في الكتاب الإنجليزي (المصدر) حيث دائما ما يتفانى معي هذا الأستاذ الكريم بتقديم نصائح وتوجيهات لغوية راقية أثمرت عن تحسين لغتي وتهذيب أسلوبها، وإن كنت مازلت بحاجة ماسة إلى التقويم المستمر والمعونة اللغوية الدائمة. وقد بشرنا الأستاذ نتظر أنه رُزق بمولوده الأول واسماه “ريان” حفظه الله وجعله من الذرية الصالحة، وألف مبروك يا أبا ريان.
——————-
كلمة لا شكر ولا عرفان: أوجهها إلى بعض القائمين على دور النشر العربية، لاسيما الحكومية منها، التي لا يبدو أن أيًا منها تتحلى جديًا بمقومات المبادرة وحمل هم التنوير والارتقاء بالشباب العربي الذي يراد له أن يبقى على جهل وظلام بما يدور حوله من سباق التطور نحو المعرفة. لقد راسلت بشأن مشروع ترجمة هذا الكتاب ما لايقل عن 50 أو ربما 60 دار نشر عربية، لم يرد عليّ سوى إثنتين منها. الأولى هي مجلة عالم المعرفة التابعة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتية، وهي مجلة تنشر كتبا معرفية دوريا ولها باع طويل في هذا المضمار، وهي كذا هيئة حكومية ويفترض ألا تهمها مسألة الربح والخوف من الخسارة كما هو حال دور النشر التجارية الأخرى. لكن تفاجأت بقانون فرضوه يمنع تمويل نشر أي كتاب تزيد عدد صفحاته عن 350 صفحة. فقلت لهم إنكم تتعاملون هكذا بمنطق “الكيلو” كما حال سوق الخضار؟ فردوا بلامبالاة “هذا اللي عندنا” فلم أملك سوى الحوقلة والاحتساب. ثم لاحظت لاحقا إن إدارة هذه المجلة من الأسماء “الوطنية” الشابة، فتأسفت على حقبة الأسماء العربية اللامعة من مصر وفلسطين التي أدارت هذه المجلة منذ صدورها في آواخر السبعينيات، حيث لا ينظرون إلى المعرفة بعدد صفحات الكتاب بل إلى قيمته المعرفية ومدى ما تنشره من تنوير بموقع أقدامنا من السباق الحضاري الذي لا يتوقف قط. فأدركت أننا بمعية شباب الجيل وشاباته” سنعاني من الهزال المعرفي الجاد والركون إلى معلومة “تيك أواي والهوم ديليفيري”. أما الرد الثاني، فجاءني من دار الساقي ومديرته التنفيذية التي اشتكت من اضمحلال التوجه للقراءة وشراء الكتب بعد “الربيع العربي” حيث تسمر الناس عند شاشات التلفاز ترقبا للأحداث المتواصلة التي لا تكاد تنتهي ولم يعد يهتم أحد بالقراء، كما هو السائد لدى دور النشر وروادها. ويبدو أن كثيرا من أصحاب دور النشر دخلوا في دائرة عداء للربيع العربي نظرا للكساد الذي تسبب فيه، لا لسبب آخر (قال يعني إن السيدة ودارها سينشرون الكتاب قبل ذلك الربيع حتى لو تجاوزت صفحاته الألف!). فقلت لها: وهل لديكِ حل؟ فردت قائلة: طبعا معلوم، تدفع حضرتك كل التكاليف ونحن نطبع لك الكتاب بكل سرور. فتساءلت: وبعدين؟ فردت: وبعدين يا سيدي نشحن لك كل النسخ وأنت تتصرف. فضحكت ساخرا: لاو الله حلو ومليح، وأنا أخزن وأصور “سيلفي” مع النسخ المخزنة إرضاء للغرور، مع أنني لا امتلك مخزنا أصلا. وانتهى النقاش بلا نتيجة ولا ترجمة. لا ألوم السيدة مديرة دار الساقي العريقة بطبيعة الحال، فهي دار تجارية وهذه العملية محفوفة بمخاطرة الخسارة، بالرغم من أن كثيرين أكدوا أن أي دار نشر لن تخسر على المدى البعيد من طباعة أي كتاب. ومن ناحية شخصية، لو أن دار نشر خاصة تعاقدت معي، فسأقدر ظروفها طبعا، وسأرضى بنسبة محددة ومتفق عليها سلفا من الأرباح. لكن يبدو جليا لي أنه فعلا لا اهتمام بنشر أية كتب جادة.
عن مؤلف الكتاب

إيان موريس: بروفيسور بريطاني بارز وحاصل على مقعد تدريس إشرافي في قسم الدراسات الكلاسيكية في جامعة ستانفورد الأمريكية، وهو مؤرخ وعالم آثار بارز. وكتب بعد كتابه هذا كتابا بعنوان “الحرب، وما نفع الحرب!” مقتبسا عنوان الأغنية الشهيرة في سبعينيات القرن الماضي: War! What Is It Good For? يمكن الاطلاع على سيرته من خلال صفحته في الوكيبيديا من هنا.
أنشأت هنا ملفا بصيغة PDF يحتوي على النص الإنجليزي للمقدمة لمن يرغب في الإطلاع والمقارنة
[frame="12 98"]المقدمة
[/frame]
[frame="12 98"][/frame]
ألبيرت في بكين

لندن، في الثالث من أبريل/نيسان عام 1848، رأس الملكة فيكتوريا يوجعها. لقد كانت راكعة ووجهها يلامس عمودا خشبيا في رصيف المرفأ لمدة عشرين دقيقة. وشعرَت بالغضب والخوف والسأم من مقاومة الدموع، والآن بدأ المطر بالهطول. أخذ رذاذ المطر يبلل ثوبها، ولم تتمنَ سوى ألا يفسر أحد بالخطأ رجفاتها على أنها بدافع من الخوف.
كان زوجها بجانبها، ولو مدّت ذراعها لأمكنها وضع يدها على كتفه أو أن تملّس شعره المبتل -عمل أي شيء للشد من أزره لمواجهة ما هو قادم، لو أن للوقت أن يتجمّد- أو أن يمضي أسرع. تتمنى لو أنها هي والأمير ألبيرت يتواجدان في أي مكان إلا هذا المكان.
وهكذا انتظروا جميعا -فيكتوريا وألبيرت ودوق ويلينجتون ونصف البلاط الملكي- وهم جاثون على ركبهم تحت المطر. من الواضح أن ثمة مشكلة بالنهر فمقدمة الأسطول الصيني الرئيس كبيرة على مرافئ ضفة إيست إنديا حتى تبحر فيه. فإذًا، كان الوالي تشيينغ يستعرض بدخوله الفخم إلى لندن من قارب بخاري مدرّع صغير أسماه على اسمه، لكن حتى قارب تشيينغ هذا كبير أيضا على مرافئ بلاك وول مما يصعب من رسوّه. وكانت قوارب سحب زنة نصف طن تقطره لداخل المرفأ وهو ما جعل الارتباك يعم المكان. أما تشيينغ فلم يشعر بالتسلية.
نظرت فيكتوريا بطرف عينها فرأت فرقة موسيقية صينية صغيرة متواجدة على الرصيف. وبدت ملابسهم الحريرية وقبعاتهم الغريبة خلابةً قبل ساعة مضت، لكن المطر الإنجليزي بتلك اللحظة أفسدها وجعلها مبتلة تماما. عزفت الفرقة أربع مرات بعضا من المقاطع الشرقية المتنافرة ظنًا منها أن النقالة التي سيُحمل عليها تشيينغ ليصل للشاطئ قد وضعت، لكنها توقفت عن ذلك أربع مرات، أما المرة الخامسة فواصلت فيها. أخذت معدة فيكتوريا تتحرك فجأة، فلا بد أن تشيينغ قد وضع أقدامه على الشاطئ أخيرا، وهذا ما حدث فعلا.
ثم كان أن تواجد مبعوث تشيينغ أمامهم مباشرة وإلى درجة قريبة منهم بحيث أمكن لفيكتوريا رؤية أشكال التطريز على نعاله، فثمة تنانين صغيرة ولهب ودخان منفوخ، لا بد أنه صنعٌ أكثر اتقانًا مما تجيده أميرات ووصيفات بلاطها.
طفق المبعوث يتحدث بكلام طويل ممل قارئًا إعلانًا صادرًا من بكين. وقد أُبلغت فيكتوريا مسبقًا بمحتواه الذي يتمحور حول التالي: يقرّ النموذج الأعظم والإمبراطور المستنير داوغوانغ برغبة الملكة البريطانية في نيل شرف مقابلة صاحب الجلالة الإمبراطورية التي توسلت فيكتوريا من أجل الحصول على فرصة تقديم الجزية والضرائب لدفع أقصى آيات الاحترام والإجلال والتعرف على أي أمر يأمر به جلالة الإمبراطور، الذي وافق على معاملة أرض مملكتها باعتبارها إحدى مقاطعاته الداخلية، وأن يسمح جلالته للبريطانيين بالاحتذاء حذو أسلوب الحياة الصيني.
وقد علم جميع الناس في بريطانيا ما حدث فعلا. ففي البداية كان الصينيون محط ترحاب، حيث أسهموا بتمويل الحرب ضد نابليون الذي أغلق منافذ القارة عليهم. لكن منذ العام 1815، أخذوا يبيعون بضائعهم بأسعار منخفضة باستمرار في الموانئ البريطانية إلى أن تسببوا بإيقاف العمل في مطاحن قطن لانكشاير. وعندما اعترض البريطانيون ورفعوا قيمة التعرفة الجمركية، أحرق الصينيون البحرية الملكية (البريطانية) المزهوة بذاتها وقتلوا الأدميرال نيلسون واجتاحوا كل البلدات المطلة على الساحل الجنوبي. ولمدة قاربت الثمانية قرون، كانت إنجلترا عصيّة على جميع الغزاة، لكن اسم فيكتوريا الآن سيوصم بالعار بسجلات التاريخ وسينزلق عهدها إلى أفظع مساوئ تفشي القتل والسلب والنهب والاختطاف وكذلك عار الهزيمة والخزي والهلاك. وها هو تشيينغ يأتي بنفسه، وهو المهندس الشرير لإرادة الإمبراطور داوغوانغ، ليزيد من طين السوء بلة الهراء والنفاق.
يتنحنح مترجم فيكتوريا الذي يجلس راكعا خلفها في الوقت المناسب بكحة ملائمة لا يسمعها سوى الملكة. كانت هذه هي الإشارة: وصل موظف تشيينغ إلى الجزء الذي يتحدث فيه عن توظيفها كحاكمة تابعة. رفعت فيكتوريا جبينها ونهضت لتستلم القبعة والرداء البربري الذين رمزا إلى عار شعبها، وألقت أول نظرة فاحصة على تشيينغ الذي لم تتوقع رؤية رجل بمتوسط العمر ذكي ومفعم بالحيوية مثله. هل يمكنه فعلا أن يكون ذلك الوحش الذي توجست منه خيفة؟ ألقى تشيينغ من جانبه أولى نظراته على فيكتوريا، وهو كان قد رأى لوحة مرسومة لها إبان تتويجها، لكنها بدت الآن أكثر بدانة وبساطة مما توقع، وصغيرة السن جدا جدا. إلا أن المطر بلل ملابسها وظهرت عليها بعض الآثار من الطين وقليل من شظايا خشب المرفأ على وجهها. إنها لم تعرف حتى كيف تسجد سجود (الكاوتاو) سجودا سليما. يا لهم من قوم ناكرين للنعمة.
وأتت الآن أكثر اللحظات إثارة للرعب المفجع، إنها اللحظة التي لا يمكن تخيلها. تقدم شخصان صينيان من خلف تشيينغ بعد انحنائهما انحناءات احترام نحو ألبيرت وساعداه على النهوض على قدميه. أدركت فيكتوريا أن عليها ألا تصدر صوتا أو أن تتحرك أية حركة- وإحقاقا للحق، وقفت بلا حراك، ولم يمكنها الاعتراض فيما لو حاولت.
اقتادوا ألبيرت الذي تحرك ببطء وزهو، ثم ما لبث أن توقف ونظر لفيكتوريا من خلفه نظرة تختزل كل ما في الدنيا من مشاعر.
أغمي على فيكتوريا، إلا أن مرافقا صينيا أمسك بها قبل أن تقع على أرضية المرفأ. لن يجدي الملكة نفعا أن تؤذي نفسها بمثل هذا اللحظة، حتى لو كانت ملكة للعلوج. أما ألبيرت، الذي تجمدت تعابير وجهه وتنفس لاهثا، فقد غادر بلاده التي انتمى إليها، عند صعوده لسلم السفينة، ودخوله للقمرة المغلقة الفاخرة، وتوجه نحو الصين، حيث سيعامل كخادم للإمبراطور ذاته في المدينة المحرّمة.
كان ألبيرت قد رحل في الوقت الذي تعافت فيه فيكتوريا، التي عذّبت جسدها تنهيدات عميقة. تستغرق رحلة ألبيرت للوصول إلى بكين نصف العام وذات المدة للعودة، وقد ينتظر هناك مزيدا من الشهور أو الأعوام وهو وسط هؤلاء البرابرة إلى أن يسمح له الإمبراطور بالحضور أمامه. فماذا ستفعل؟ وكيف لها أن تحمي شعبها لوحدها؟ وكيف ستواجه تشيينغ الشرير هذا بعد أن فعل بهم ما فعل؟
لم يرجع ألبيرت أبدا، فقد وصل إلى بكين وأدهش البلاط الإمبراطوري بإجادته للغة الصينية ومعرفته بالفلسفة الكونفوشية القديمة. لكن إثر وصوله جاءت أنباء بأن عمّال المزارع الفقراء قد ثاروا وحطموا الآلات في أنحاء جنوب إنجلترا. ثم ما لبثت أن اندلعت معارك شوارع دموية في نصف العواصم الأوروبية. وتلقى الإمبراطور رسالة بعد بضعة أيام قادمة من تشيينغ يقترح فيها مستحسنا الإبقاء على أمير موهوب كألبيرت بعيدا عن بلاده. كل ذلك العنف لم يكن سوى مرحلة من مراحل الانتقال نحو الحداثة كالتي تتمتع بها الإمبراطورية الصينية، لكن لم يكن ثمة معنى للمجازفة مع هؤلاء الناس المضطربين.
بقي ألبيرت في المدينة المحرمة، وألقى عنه رداؤه الإنجليزي وأطال ذيل شعره ليماثل شعر قوم المانشو، وفي كل عام يمر تتعمق معرفته بالدراسات الصينية القديمة. أصابه الهرم وقضى وقته وحيدا ما بين السرادق، وبعد أن عاش ثلاثة عشر عاما في قفص ذهبي وافته المنية دون صخب.
وفي الشطر الآخر من العالم، انعزلت فيكتوريا في غرف خاصة يكتنفها البرد في قصر بكينغهام وتجاهلت أسيادها المستعمرين. أدار تشيينغ بريطانيا بغيابها بكل بساطة. أما كثير ممن يطلق عليهم السياسيون فكانوا يزحفون على بطونهم لعقد الصفقات معه. لم تقم جنازة رسمية عندما توفيت فيكتوريا عام 1901، بل مجرد ابتسامات ساخرة وعدم اكتراث لمرور الرفات الأخير للعصر من أمام الإمبراطورية الصينية.
لوتي في (بالمورال)

أما على أرض الواقع، فإن الأمور بطبيعة الحال لم تحدث بالطريقة آنفة الذكر، أو على الأقل فقط بعض منها تحقق فعلا. فقد كانت توجد سفينة باسم تشيينغ وأبحرت فعلا نحو مرافئ إيست إنديا في لندن وذلك في أبريل/نيسان من عام 1848 (الشكل م.1). لكنها لم تكن سفينة حربية مدرعة تحمل على ظهرها حاكما للندن. فسفينة تشيينغ الحقيقية لم تكن سوى سفينة شراعية خشبية مزركشة الصبغ، وقد ابتاع تلك السفينة الصغيرة تجّار بريطانيون في المستعمرة الملكية هونغ كونغ قبل سنتين من ذلك التاريخ ورأوا أن من المبهج أن يأتوا بها إلى عاصمة الضباب.
والملكة فيكتوريا والأمير ألبيرت ودوق ويلينغتون جاؤوا فعلا لمرفأ النهر، لكن ليس للسجود لحاكمهم الجديد، بل حضروا لقضاء بعض الوقت للنظر إلى أول سفينة صينية يشاهدها الناس في بريطانيا.
والسفينة اسمها على اسم حاكم غوانجو. لكن تشيينغ لم يقبل إذعان بريطانيا بعد تدمير أسطولها الملكي عام 1842 (فهذا كله محض خيال). فما حدث حقا أنه تفاوض على استسلام الصين بذات العام، وذلك بعد إغراق أسطول بريطاني صغير لجميع السفن الشراعية الحربية الصين التي كانت بمتناوله، وأخمد المدافع الساحلية، وأغلق القناة الكبيرة التي تربط بكين بوادي يانغتزي الغني بالرز، ومهددين بذلك العاصمة بالحصار والمجاعة.
والإمبراطور داوغوانغ حكم الصين فعلا عام 1848، لكنه لم يمزق قلبي فيكتوريا وألبيرت. فحقيقة الأمر أنهما كزوجين عاشا حياتهما بسعادة نغّصتها بعض حالات فيكتوريا المزاجية، إلى أن وافت المنية آلبيرت عام 1861. ويسطّر الواقع أن فيكتوريا وآلبيرت هما من مزقا داوغوانغ تمزيقا.

شكل م.1. سفينة تشيينغ الحقيقية: اكتظت القوارب بالفضوليين من أهل لندن لرؤية السفينة عام 1848، كما صور ذلك رسام من جريدة إلوستريتد لندن نيوز
إن التاريخ غالبا ما يتسم بالغرابة التي تفوق الخيال. لقد قضى مواطنو فيكتوريا على داوغوانغ وحطموا إمبراطوريته من أجل شيء بسيط يرتبط بأسوأ العادات البريطانية- ألا وهو كأس من الشاي (أو بالأحرى بضعة مليارات من كؤوس الشاي على وجه الدقة). في العقد الأخير من القرن الثامن عشر، كانت شركة الهند الشرقية، التي تحكم معظم جنوب آسيا كإقطاعية خاصة، تشحن ما قيمته 23 مليون جنيه إسترليني من أوراق الشاي الصيني إلى لندن سنويا. والأرباح من جراء ذلك هائلة، إلا أن ثمة مشكلة: لم تهتم الحكومة الصينية باستيراد البضائع البريطانية كتبادل تجاري، فكل ما أرادته هو الفضة، بينما واجهت الشركة مشاكل جمة بجمع ما يكفي منه للحفاظ على سير مجرى هذه التجارة. غير أن البهجة عمت أوساط التجار عندما أدركوا أن الشيء الذي تريده الحكومة الصينية كان الشعب الصيني يريد عكسه، ألا وهو الأفيون. وأجود أنواع الأفيون يوجد في الهند التي تسيطر على مقدراتها الشركة. فباع التجار في ميناء غوانجو -وهو الميناء الوحيد الذي يستطيع فيه التجار الأجانب إجراء التبادلات التجارية- الأفيون مقابل الفضة، واستخدموا الفضة لشراء الشاي، ثم باعوا الشاي بأرباح أعظم في لندن.
بيد أن حل مشكلة معينة ينتج عنه ظهور مشكلة أخرى، كما هو الحال السائد في معظم الأعمال التجارية. فالهنود كانوا يأكلون الأفيون، أما البريطانيون فيذيبونه ويشربونه، مستهلكين بذلك ما مقداره عشرة إلى عشرين طنا سنويا (يذهب بعض منه لتنويم الأطفال الرضع وتهدئتهم). وعملت كلتا الطريقتان على ظهور تأثيرات تخديرية معتدلة تكفي لإشعال خيال أغرب الشعراء وإثارة جماح قلة من النبلاء والأمراء للوقوع في ملذات إغواء جديدة، لكن ما من شيء للقلق. أما الصينيون، من الجهة الأخرى، فأخذوا يدخنون الأفيون. ولم يكن الفرق بين شربه وتدخينه يختلف عن الفرق بين مضغ أعشاب الكوكا وإشعال غليون يحتوي على مخدر الكوكايين. فعمل تجار المخدرات البريطانيين على إيجاد كافة السبل للتغاضي عن هذا الفرق، غير أن داوغوانغ لم يتغاضَ عنه، فأعلن في سنة 1839 الحرب على المخدرات.
لقد كانت حربا غريبة، سرعان ما تحولت إلى مواجهة شخصية بين قائد مكافحة المخدرات المفوّض لين زيتزو والمشرف على التجارة البريطاني في غوانجو القبطان تشارلز إيليوت الذي عندما أدرك أن هزيمته وشيكة أقنع التجّار بتسليم كمية هائلة من الأفيون تبلغ 1700 طن إلى لين، وجعل التجّار يوافقون على هذا مقابل الضمان بأن تعوض الحكومة البريطانية خسائرهم. لم يعلم التجّار ما إذا كان إيليوت يمتلك فعلا التخويل لتقديم وعد كهذا، لكنهم على الرغم من ذلك تلقفوا هذا العرض بسرور. فحصل لين على الأفيون، وحافظ إيليوت على ماء وجهه وعلى استمرار حركة التجارة بانسياب، أما التجّار فحصلوا على أعلى سعر لمخدراتهم (بالإضافة إلى الفائدة والشحن). فنال الجميع مرادهم، باستثناء اللورد ميلبورن رئيس وزراء بريطانيا، الذي كان منتظرا منه توفير مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني لتعويض تجار المخدرات. وبالرغم من أن حشر رئيس وزراء بالزاوية على يد مجرد قبطان بحري يعد من أفعال الجنون المحض، إلا أن إيليوت أيقن أن بإمكانه الاعتماد على فئة رجال الأعمال لتشكيل مجموعة ضغط في البرلمان لاستعادة الأموال. وهكذا أدت المصالح الشخصية والسياسية والمالية إلى تكثيف الضغوط حول ميلبورن الذي لم يجد بدًّا من تسديد النفقات ثم إرسال بعثة لإجبار الحكومة الصينية على تعويض بريطانيا عن الأفيون المُصادَر. (الشكل م.2.)
هذه ليست أزهى لحظات الإمبراطورية البريطانية. والمواقف المماثلة ليست بذات الدقة لتشبيه ما جرى آنذاك، لكن ذلك يقترب من تخيلنا لردة فعل قد تحدث عند قيام وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بغارة كبرى على العصابة المنظّمة في تيخوانا[1] التي تنجح في التغلب على الحكومة المكسيكية لتشق طريقها نحو سان دييغو بعد مطاردة دامية، فيطالب المكسيكيون البيت الأبيض بتعويض زعماء عصابات المخدرات عن قيمة الكوكايين المُصادَر (مضافا إليه قيمة الفائدة ونفقات العربات) ناهيك عن دفع مصاريف الحملة العسكرية. ولنتخيّل كذلك أن أسطولا مكسيكيا هجم على جزيرة كاتالينا وجعلها قاعدة للعمليات المستقبلية وهدد بمحاصرة واشنطن ما لم يمنح الكونغرس زعماء عصابات المخدرات بتيخوانا حقوقا احتكارية في لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك.
وبطبيعة الحال فإن الفرق يكمن في عدم قدرة المكسيك على قصف سان دييغو، بينما كانت بريطانيا قادرة في عام 1839 على فعل ما تشاء. فقد تجنبت السفن البريطانية الدفاعات الصينية ووقّع تشيينغ معاهدة مذلّة مما فتح الصين على مصراعيها للتجارة والإرساليات التبشيرية. ولم تُنتزع زوجات داوغوانغ منه ليقتدن إلى لندن كما في الطريقة التي ذهب بها ألبيرت إلى بكين والتي تخيلتُها في المشهد الوارد في بداية هذه المقدمة، لكن بالرغم من ذلك حطمت “حرب الأفيون” داوغوانغ الذي خذل 300 مليون نسمة من رعاياه وانتهك تقليدا استمر لإلفي عام. وكان محقا بشعوره بالفشل الذريع، فالصين تتمزق والإدمان يتفشى والدولة تفقد سيطرتها وأعراف المجتمع تنهار.

الشكل م.2. لحظة ليست من أزهى لحظاتهم التاريخية: السفن البريطانية وهي تقصف السفن الشراعية الصينية قريبا من نهر يانغتزي عام 1842.
وتظهر على أقصى يمين الصورة السفينة نيميسيس[2] وهي أول سفينة حربية مدرعة بالكامل في العالم واستمرت بالعمل لتكون اسما على مسمى
وتظهر على أقصى يمين الصورة السفينة نيميسيس[2] وهي أول سفينة حربية مدرعة بالكامل في العالم واستمرت بالعمل لتكون اسما على مسمى
في ظل هذه الأحوال الملتبسة، ظهر مرشح غير موفّق لشغل وظيفة في الخدمة العامة واسمه هونغ زيوجوان، وقد ترعرع في منطقة قريبة من مدينة غوانجو. وشدّ هونغ رحاله بمشقة أربع مرات للمدينة لأداء الاختبارات القاسية لقبول الدخول للوظيفة العامة، ورسب في كل المرات الأربع. فانهار في المرة الأخيرة عام 1843 ولم يقوَ على العودة لقريته إلا محمولا على الأكتاف. صعدت به الملائكة، في الأحلام التي انتابته وهو مصاب بالحمى، إلى الجنة حيث قابل رجلا قيل له إنه أخاه الأكبر. فتقاتل الرجلان جنبا إلى جنب ضد الشياطين تحت أنظار والدهما ذي اللحية.
لم يفهم أحد من القرية هذا الحلم، وبدا أن هونغ نسي أمره عددا من السنين إلى أن فتح بيوم ما كتابا صغيرا أُعطي إليه في غوانجو بإحدى رحلاته إلى قاعة الاختبارات. ذلك الكتاب يلخص النصوص المسيحية المقدسة، فأدرك هونغ المغزى وتمسك بسر حلمه. ومن الجلي أن الأخ الأكبر لم يكن سوى اليسوع ذاته، وهو ما جعل من هونغ ابنا صينيا للرب. لاحق هونغ برفقة اليسوع الشياطين طاردين إياهم من الجنة، لكن الحلم بدا وأنه يشير إلى أن الرب يريد من هونغ أن يطردهم من الأرض أيضا. أعلن هونغ، بعد خلطه للمسيحية البروتستانتية بالكونفوشية خلطة أقرب للترقيع، عن إقامة المملكة السماوية للسلام العظيم. فتجمع من حوله الفلاحون الحانقون وقطّاع الطرق. وبحلول عام 1850، هزمت جماعته المتنافرة الجيوش الإمبراطورية غير المنظمة التي أُرسلت إليه، وانصاع لإرادة الرب بتطبيق إصلاحات اجتماعية جذرية. فأعاد توزيع الأراضي وشرع حقوقا متساوية للنساء بل وحظر استخدام عادة ربط الأقدام[3].
في الوقت الذي كان الأمريكيون يفتكون ببعضهم بعضا بالمدافع والبنادق النارية في بداية عقد الستينات من القرن التاسع عشر في الحرب الحديثة الأولى من نوعها في العالم، كان الصينيون يقومون بذات الشيء بالقطالس[4] والرماح في آخر الحروب التقليدية في العالم. ومما يثير الرعب المطلق أن الحرب التقليدية فاقت مثيلتها الحديثة بأعداد القتلى حيث لقي 20 مليون نسمة مصرعهم، أغلبهم بسبب المجاعة والأمراض، فاستغل الدبلوماسيون والقادة العسكريون الغربيون هذه الفوضى ليزيدوا من توغلهم نحو شرق آسيا. وفي عام 1854، أجبر القائد البحري الأمريكي بيري اليابان على فتح موانئها للملاحة إثر بحثه عن مراكز للفحم في الطريق الطويل ما بين كاليفورنيا والصين. وفي عام 1858، نجحت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالحصول على امتيازات جديدة من الصين. فالإمبراطور شيانفينغ، الذي بَغَض العلوج الأجانب لأنهم حطموا والده داوغوانغ، وكان بتلك الأثناء يستغل ظروف حربه ضد هونغ، حاول التملص من المعاهدة الجديدة، لكن عندما صعب الموقف على شيانفينغ، قدمت له الحكومتان البريطانية والفرنسية عرضا لا يستطيع رفضه. فقد زحفتا نحو بكين وأُجبر شيانفينغ على الانعزال في مأوى مهين بموقع استجمام قريب، ثم أحرق الأوروبيون قصره الصيفي الجميل فجعلوه يتيقن من قدرتهم على فعل ذات الأمر بالمدينة المحرمة إذا شاؤوا، فأذعن شيانفينغ. بل تحطم إلى أشلاء بأقسى مما تحطم أبيه، فرفض الخروج من مخبئه أو مقابلة أحد من المسؤولين بعد ذلك مطلقا، وانغمس بتعاطي المخدرات وممارسة الجنس، ومات في السنة التالية.
لفظ الأمير ألبيرت أنفاسه الأخيرة بعد وفاة شيانفينغ. وعلى الرغم أنه قضى أعواما بتنظيم حملات لإقناع الحكومة البريطانية بأن مجاري تصريف المياه السيئة تنشر الأمراض، إلا إن ألبيرت قضى نحبه على الأرجح بمرض التيفوئيد الذي جاء من مجاري قصر وندسور البائسة. غير إن فيكتوريا -المولعة بالسباكة الحديثة كألبيرت- كانت في الحمام عند وفاته.
وقعت فيكتوريا في غياهب نوبات حزن وكآبة بعد أن حُرمت من حب حياتها. بيد أنها لم تكن وحيدة تماما، فقد جلب لها الضباط البريطانيون إحدى أرقى الهدايا التي نهبوها من القصر الصيفي في بكين: كلب من بكين، اسمته لوتي[5].
الحتمية والديمومة
لماذا سار التاريخ بالمسار الذي أتى بـ(لوتي) إلى قصر بالمورال ليعيش هناك ويكبر مع فيكتوريا بدلا من المسار الذي يأتى بألبيرت ليدرس الكونفوشية في بكين؟ ولماذا شقّت السفن البريطانية طريقها نحو نهر يانغتزي بإطلاق نيران مدافعها بدلا من أن تفعل ذلك السفن الصينية لتصل إلى نهر التيمز؟ لنطرح السؤال بصيغة أخرى أوضح: لماذا يهيمن الغرب؟
ومقولة إن الغرب “يهيمن” قد تبدو شديدة وقوية بعض الشيء؛ فمهما عملنا على تعريف مفهوم “الغرب” (وهي مسألة سأعود إليها خلال صفحات قليلة)، فإن الغربيين لم يديروا بالضبط حكومة تتصف بالعالمية الشاملة منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر، وفشلوا مرارا في تحقيق مساعيهم ونظمهم الخاصة بهم. كثير منّا يتذكر الخروج الأمريكي العشوائي المهين من مدينة سايغون عام 1975 (أصبحت الآن تسمى هوشي منه)، وكذلك الطريقة التي تفوقت بها المصانع اليابانية على نظيراتها الغربية وأخرجتها من المنافسة في الثمانينات. وحتى كثير منّا حاليا لديهم ذلك الإحساس بأن كل شيء نشتريه قد صُنِع في الصين. غير أن من الجلي كذلك أنه خلال المائة سنة المنصرمة أو نحوها أرسل الغربيون الجيوش نحو آسيا وليس العكس. وعانت الحكومات الشرق آسيوية من النظريات الرأسمالية والشيوعية الغربية، بل ما من حكومة غربية حاولت أن تحكم حسب النموذج الكونفوشي أو الطاوي. ويتجاوز الشرقيون الحواجز اللغوية فيما بينهم غالبا من خلال استخدام اللغة الإنجليزية؛ أما الأوروبيون فمن النادر أن يفعلوا ذلك باستخدام لغة الماندارين أو اليابانية. فكما ذكر بصراحة أحد المحامين الماليزيين للصحفي البريطاني مارتين جاك “إنني أرتدي ملابسكم وأتحدث لغتكم وأتفرج على أفلامكم، وحيث يكون تاريخ اليوم فهو تقويمنا لأنكم تقولون ذلك.”[6]
وللقائمة أن تطول، فمنذ أن خطف جنود فيكتوريا لوتي الكلب فإن الغرب حافظ على هيمنته على العالم بشكل لا مثيل له في التاريخ.
إن هدفي يتمثّل بتوضيح هذا الأمر.
ربما لا يبدو للوهلة الأولى أنني كرست نفسي لمهمة شديدة الصعوبة. فكل الناس تقريبا يتفقون على أن الغرب يهيمن على العالم بسبب حدوث الثورة الصناعية فيه، لا في الشرق. ونجح روّاد الأعمال البريطانيون بإطلاق الطاقة البخارية والفحم. فالمصانع وسكك الحديد والسفن المجهزة بالمدافع منحت الأوروبيين والأمريكيين في القرن التاسع عشر القدرة على إبراز قوتهم عالميا، أما في القرن العشرين فقد سمحت مخترعات الطائرات وأجهزة الحاسوب والأسلحة النووية لمن خلفهم بتوطيد هذه الهيمنة.
لا يعني هذا بطبيعة الحال أن كل الأمور كان يجب أن تؤول إلى ما آلت إليه بالضبط. فلو لم يلوِ القبطان إيليوت ذراع اللورد ميلبورن عام 1839 لما هاجم البريطانيون الصين في تلك السنة، ولو أن المفوّض لين اهتم بتكثيف دفاعاته الساحلية على نحو أكبر لما نجح البريطانيون بغزوهم بتلك السهولة. على أن ذلك يعني، بغض النظر عما صارت إليه الأمور وعن من جلس على العروش ومن فاز بالانتخابات أو قاد الجيوش، أن انتصار الغرب واقع لا محالة بالقرن التاسع عشر. وقد لخّص الشاعر البريطاني هيلير بيلوك ذلك بإطار أدبي متقن بقصيدة له في عام 1898 قائلا:
مهما صار من أمور ومهما حصل
مدافعنا تعلوهم ورميهم ما وصل[7]
انتهت القصة.
باستثناء طبعا أن هذه ليست نهاية القصة، بل تثير سؤالا جديدا: لماذا حاز الغرب على المدافع الأقوى ولم تحزه بقية مناطق العالم؟ هذا السؤال الذي أناقشه هنا، لأن الإجابة تميط اللثام عن السبب الذي يجعل الغرب يهيمن حاليا؛ وإن استثمرنا هذه الإجابة فإن باستطاعتنا طرح سؤال ثان. فأحد الأسباب التي تثير اهتمام الناس حول تفسير هيمنة الغرب هو تلك الرغبة بمعرفة المدة التي ستستغرقها هذه الهيمنة وكيفيتها- أي، ما الذي سيحدث تاليا؟
لقد غدا هذا السؤال أكثر إلحاحا مع انقضاء القرن العشرين وبروز اليابان كقوة كبرى، وأمسى ذات السؤال فارضا نفسه بقوة في القرن الواحد والعشرين. فحجم الاقتصاد الصيني يتضاعف كل ست سنوات وسيصبح على الأرجح أضخم اقتصاديات العالم قبيل حلول عام 2030. وأضحى معظم الاقتصاديين، في هذه اللحظة التي أكتب فيها الكتاب في بداية عام 2010، يتطلعون إلى الصين، لا لأمريكا ولا لأوروبا، لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد العالمي. وقد استضافت الصين دورة الألعاب الأوليمبية عام 2008 بنجاح باهر وقام رائدا فضاء صينيان بالمشي بالفضاء. كما أن الصين وكوريا الشمالية تمتلكان أسلحة نووية، ويشعر إستراتيجيو الغرب بالقلق من الكيفية التي ستضع بها الولايات المتحدة نفسها بمواجهة تصاعد قوة الصين. فالسؤال حول المدة التي سيبقى الغرب فيها متبوّءا القمة هو سؤال يستفز العقول لإجابة ملحّة.
يُشتهر عن المختصين بالتاريخ افتقارهم للقدرة على التنبؤ بالأحداث إلى الحد الذي يجعلهم يرفضون مطلقا التحدث عن المستقبل. على أنني كلما أمعنت التفكير بأسباب هيمنة الغرب، أدركت أن فهم المؤرخ ونستون تشرشل للأمور-وهو غير المتخصص- أفضل بأشواط كبيرة من فهم معظم المتخصصين، حيث يشدّد قائلا ” كلما ابتعدتَ بالنظر للماضي فإن فرصك لرؤية المستقبل البعيد تزداد.”[8] وبالسير على خطى هذا النهج (حتى لو لم ترق استنتاجاتي لتشرشل)، سأقترح أن معرفة أسباب هيمنة الغرب تمنحنا إدراكا جيدا جدا للكيفية التي ستؤول إليها الأمور في القرن الواحد العشرين.
لا شك أنني لست أول شخص يتأمل في أسباب هيمنة الغرب، فالمسألة مطروحة منذ ما يزيد على 250 سنة. ونادرا ما أُثير الموضوع للتساؤل قبل القرن الثامن عشر لأنه في الحقيقة لم يكن له كبير معنى آنذاك. وعندما بدأ المفكرون الأوروبيون بالتفكير بجدية بشأن الصين في القرن السابع عشر، شعر أكثرهم بالتواضع أمام عراقة ورقي الشرق؛ ولا بد أن قلة من الشرقيين الذين لم ينتبهوا كثيرا للغرب قالوا ذلك أيضا. فصحيح أن بعض المسؤولين الصينيين أعجبوا بالساعات الغربية المخترعة والمدافع الشيطانية والتقاويم السنوية الدقيقة، غير أنهم لم يروا كثيرا مما يستحق التقليد من أولئك الأجانب الأغيار غير المثيرين للإعجاب. لو أن أباطرة الصين في القرن الثامن العشر علموا أن الفلاسفة الفرنسيين كفولتير مثلا كتبوا القصائد في مدحهم، لربما ظنوا أنه استحقاق واجب على الفلاسفة الفرنسيين.
بيد أنه منذ اللحظات الأولى تقريبا التي نفثت فيها المصانع الدخان وملأت بها سماء إنجلترا، أدرك المفكرون الأوروبيون أنهم يواجهون مشكلة معينة. ومع تتابع المشاكل، لم تتسم المشكلة السابقة بالسوء: فقد تبين أنهم يسيطرون على العالم، لكنهم لم يعرفوا السبب.
وقع ثوريو أوروبا ورجعيوها ورومانسيوها وواقعيوها معًا في دوامة من التخمينات حول علّة السيطرة الغربية، خالقين من جراء ذلك كمّا مربكا من النظريات والتكهنات المتعددة. وتكمن أفضل طريقة ربما للشروع بسؤال لماذا يهيمن الغرب من خلال تقسيم تلك النظريات بين مدرستين فكريتيين واسعتي النطاق، وسأطلق عليهما نظرية “الحتمية بعيدة المدى” ونظرية “الصُّدفة قصيرة المدى”. ومن نافلة القول إن أي فكرة لا تنضوي بتلاؤم تام تحت تصنيف فكري معين أو آخر، لكن هذا التقسيم ما ينفك عن كونه أسلوبا أجدى لتسليط الضوء على هذه المفاهيم وضبطها.
إن الفكرة المحورية التي تقف وراء نظريات الحتمية بعيدة المدى تتمثل بعامل حاسم تشكّل في غابر العصر والأوان وجعل من مسألة اختلاف الشرق والغرب أمرا هائلا وغير قابل للتغيير، وأدى إلى حسم انطلاق الثورة الصناعية في الغرب. ويختلف أصحاب نظرية المدى البعيد فيما بينهم بشدة حول ماهية ذلك العامل والزمن الذي بدأ فيه بالتمحور. فبعضهم يعزوه إلى عناصر مادية كالمناخ والطبوغرافية أو المصادر الطبيعية، ويشير بعضهم الآخر إلى مظاهر معنوية أكثر كالثقافة والسياسة أو الدين. والذين يفضلون العناصر المادية يميلون للنظر إلى “المدى البعيد” على أنه فعلا بعيد جدا. فبعضهم يعود بالنظر إلى الماضي الغابر لنحو 15 ألف سنة حتى نهاية العصر الجليدي؛ بل يعود بعض منهم لفترة أبعد من ذلك. أما أولئك الذين يشددون على الجانب الثقافي فينظرون إلى المدى البعيد على أنه أقصر من ذلك نوعا ما، حيث يمتد فقط إلى فترة ألف سنة منذ العصور الوسطى أو منذ عصر الفيلسوف الإغريقي سقراط وحقبة حكماء الكونفوشية الصينية العظماء. لكن النقطة الوحيدة التي قد يوافق عليها أصحاب المدى البعيد أن البريطانيين الذين شقوا طريقهم نحو شانغهاي باستخدام المدافع في أربعينيات القرن التاسع عشر والأمريكيين الذين أجبروا اليابان على فتح موانئها بعد ذلك بعقد من الزمان كانوا مجرد حلقات غير مدرَكة ضمن سلسلة من الأحداث دارت رحاها قبل ألف سنة من ذلك. وقد يعرب أصحاب نظرية المدى البعيد عن شعورهم بالسخافة من استهلال هذا الكتاب بمقارنة بين حالتي ألبيرت في بكين ولوتي في بالمورال. فالملكة فيكتوريا ستنتصر في كل الأحوال، والنتيجة لا مناص منها. وما تمخض كان حتميا ومتوقعا منذ أجيال بعيدة لا حصر لها.

انحصرت تقريبا جميع تفسيرات أسباب الهيمنة الغربية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 1750-1950 في فكرة الحتمية بعيدة المدى. وتمثلت أشهر المقولات في ذلك أن الأوروبيين بكل بساطة تفوقوا على الآخرين جميعا وكانت لهم اليد الطولى عليهم. فمنذ الأيام الأخيرة للإمبراطورية الرومانية، عمل أكثر الأوروبيين أولا وقبل كل شيء على تعريف أنفسهم على أنهم مسيحيون، واجتهدوا بربط جذورهم بالعهد الجديد من الكتاب المقدس، لكن أثناء سعيهم لتفسير أسباب الصعود الآني للهيمنة الغربية، تصوّر بعض من مفكري القرن التاسع عشر ومثقفيهم أنهم ينحدرون من سلالة أخرى بديلة. فقد جادلوا أنه قبل ألفي سنة ونصف، أنشأ الإغريق القدماء ثقافة فكرية نادرة الطابع تمتاز بالإبداع والحرية. وقد وجّهت هذه الثقافة مسار أوروبا نحو وجهة مختلفة (وأفضل) عن بقية العالم. وعلى الرغم من إقرارهم بأن الشرق امتلك تعاليمه وثقافته الخاصة به أيضا، غير أن تقاليده شابها الاضطراب وشدة التحفظ وعرقله التسلسل الهرمي عن منافسة الفكر الغربي. واستنتج أوروبيون كُثُر أن انتصاراتهم على جميع الشعوب الأخرى إنما حدثت بسبب الدفع الثقافي الذي أناط لهم هذا الدور.
تقبّل أغلب المفكرين الشرقيين مع حلول سنة 1900 هذه النظرية بعد أن عانوا من صعوبات جمّة باستيعاب التفوق الاقتصادي والعسكري الغربي، وإن كان بشيء من الاختلاف غير المنتظر. فقد عملت إحدى حركات “الحضارة والتنوير” في اليابان على ترجمة الآداب والفنون الكلاسيكية لحركتي التنوير الفرنسية والليبرالية البريطانية في غضون عشرين عاما من وصول القبطان البحري بيري إلى سواحل طوكيو، واجتهدت كذلك بمواكبة الغرب في الديمقراطية والتصنيع وتحرير النساء، بل أراد بعضهم جعل اللغة الإنجليزية لغةً رسمية. بيد أن المشكلة تمثلت بالمدى البعيد، كما أصرّ على ذلك مثقفون مثل فوكوزاو يوكيتشي في سبعينيات القرن التاسع عشر: فالصين ظلت المصدر الرئيس لمعظم جذور الثقافة اليابانية، والصين ذاتها باتت تعاني معاناة شديدة من الانزواء في الماضي البعيد. وما نتج عن ذلك أن اليابان لم تصبح سوى “شبه متحضرة.” لكن بينما تركزت المشكلة بكونها تقع على المدى البعيد، فإنها كذلك ، كما يجادل فوكوزاوا، لم تكن حتمية. وباستطاعة اليابان أن تصبح مكتملة التحضّر عبر رفض الصين.

ناقض المثقفون الصينيون نظراءهم اليابانيين في أنهم لم يجدوا أحدا يرفضوه سوى أنفسهم. فقد جادلت في الستينيات من القرن التاسع عشر حركة تدعى “تقوية الذات” أن التقاليد الصينية في جوهرها سليمة ولا غبار عليها، فلم يتعين على الصين سوى صناعة سفن بخارية وشراء بعض من المدافع الأجنبية. وقد تبين لاحقا خطأ هذا المنظور. إذ اجتاح سنة 1895 جيش ياباني حديث قلعة صينية اجتياحا جريئا، واستولى على المدافع غربية الصنع فيها، ووجهها نحو السفن البخارية الصينية. لقد أمست المشكلة أعمق بكثير من مجرد اختزالها بالحصول على الأسلحة المناسبة. ومع إشراقة سنة 1900، تعقّب المثقفون الصينيون أثر نظرائهم اليابانيين، فعملوا على ترجمة الكتب الغربية التي تُعنى (بنظرية) النشوء والاقتصاد. وقد استنتجوا، كما استنتج فوكوزاوا من قبلهم، أن الهيمنة الغربية كان مقدرا لها طول الأمد لكنها ليست حتمية؛ فأمكن للصين المواكبة كذلك في هذا السباق بعد نبذها لماضيها.
بيد أن بعضا من أصحاب منظور المدى الغربي البعيد اعتقد أن الشرق لم يكن بوسعه فعل أي شيء. فقد زعموا أن الثقافة جعلت الغرب غربا، لكنها ليست التفسير النهائي للهيمنة الغربية، إذ أن الثقافة ذاتها لها دوافع مادية. وجزم بعضهم أن الشرق عابته الحرارة الشديدة أو أن كثرة الأمراض في مناطقه تمنع شعوبه من تطوير ثقافة تتسم بالابتكار كما الثقافة الغربية؛ أو ربما ثمة تعداد بشري أكثر مما ينبغي في الشرق -فيستهلكون كل الفوائض، مما يجعل مستويات المعيشة منخفضة، فيمنع ذلك من نشوء أي مظهر شبيه بالمجتمع الغربي الليبرالي والمتطلع للتقدم.

تأتي نظريات الحتمية بعيدة المدى في كل صبغة سياسية، إلا إن النسخة التي يتبعها كارل ماركس ظلت هي النظرية الأكثر تأثيرا وأهمية. ففي ذات الأيام التي حررت فيها القوات البريطانية الكلب لوتي، أشار ماركس –الذي كان يكتب آنذاك مقالا عن الصين في جريدة نيويورك ديلي تريبيون- إلى أن السياسة إنما مثّلت العامل الحقيقي الذي جعل الهيمنة الغربية حتمية. فزعم أن الدول الشرقية ظلت لآلاف السنين تتمتع بالمركزية والقوة الشديدة ما جعلهم يوقفون حركة تدفق التاريخ. أما أوروبا فتطورت من العصور العتيقة مرورا بالحقبة الإقطاعية ووصولا إلى الرأسمالية، أما الثورات البروليتارية فكانت في طريقها إلى التبشير بظهور الشيوعية، لكن الشرق أصابه الانطواء في دائرة الاستبداد وعجَز عن مشاركة المسار الغربي المتطور. وعندما لم يمضِ التاريخ بالشكل الذي توقعه ماركس، واصل الشيوعيون لاحقا (لاسيما لينين وأتباعه) تحسين نظرياته وتطويرها فزعموا أن الطلائع الثورية قد يكون بمقدورها إيقاع الصدمات لزحزحة الشرق من سباته القديم. غير أن هذا لن يتأتى، كما أصرّ اللينيون، إلا إذا حطموا المجتمع العتيق والمتحجر –بأي تكلفة كانت. وهذه النظرية الحتمية ذات المدى البعيد ليست هي التفسير الوحيد لإطلاق فظائع من عقالها على يد ماوتسي تونغ وبول بوت وآل كيم في كوريا الشمالية على شعوبهم، لكنها تتحمل جزءا ثقيلا من المسؤولية.
مع انطلاقة القرن العشرين مباشرة، جرى ما يشبه حركات الرقصة المعقّدة في الغرب، إذ كشف المؤرخون النقاب عن حقائق بدا أنها لا تتناسب وأطروحات الحتمية بعيدة المدى، وقد عدّلوا من نظرياتهم ليخلقوا حالة من التواؤم معها. فعلى سبيل المثال، لا أحد يختلف الآن أن عند بداية عصر الاكتشافات الأوروبية البحرية العظمى كانت الملاحة الصينية أكثر تقدما إلى حد بعيد، وكان للبحارة الصينييين السبق بمعرفة سواحل الهند وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقية، بل وربما أستراليا أيضا[9]. فعندما أبحر الأدميرال “المخصيّ” تشينغ خه[10] من نانجينغ نحو سريلانكا سنة 1405، قاد ما يقرب من 300 سفينة برفقة صهاريج تحمل ماء شرب و”سفن كنوز” ضخمة تحركها دفّات متطورة وتحتوي على مقطورات منارة بالماء بالإضافة إلى أدوات إرسال إشارة متقنة الصنع. وضمن طاقم بحارته البالغ عددهم 27 ألف بحّار، كان هناك 180 طبيبيا وصيدلانيا. على نقيض ذلك، لم يقُد كرستوفر كولمبوس عند إبحاره من قادش سنة 1492 سوى تسعين رجلا في ثلاث سفن. أما أكبر هياكل سفنه فلا يكاد يزيح من الماء ما معدله 1 على 30 من هيكل سفن جينغ؛ أي أن صاري سفنه يقل بمعدل 25 متر عن صواري جينغ الذي يبلغ مقاس دفة سفنه ضعفي دفة سفن كولمبوس. لم يمتلك الأخير صهاريج لماء الشراب ولا أطباء حقيقيين. في حين كان بحوزة جينغ بوصلة مغناطيسية، وعَلِم ما يكفي لرسم طريق خارطة بحرية بطول 6 كيلومترات ونصف تقريبا؛ أما كولمبوس فنادرا ما عرف أين موقعه، ناهيك عن وجهته.
لعل هذه المعلومة تجعل من أي أحد يفترض أن التفوق الغربي حتمي في الماضي البعيد يعيد النظر في موقفه، غير أن عددا من الكتب الهامة جادلت أن مسألة “تشينغ خه” تتلاءم فعلا مع نظريات الحتمية، ونحن بحاجة فقط إلى نُسخ منها تتسم بالحنكة والدقة. خذ مثلا ما طرحه الاقتصادي ديفيد لانديس في كتابه الهائل “ثراء الأمم وفقرها”[11] من تجديد للفكرة القائلة إن المرض والديموغرافيا دائما ما منحا أوروبا اليد الطولى على الصين، لكنه يضيف إلتفاتة جديدة من خلال الإشارة إلى أن الكثافة السكانية قد منحت أفضلية للحكومة المركزية في الصين وقللت من دوافع حكامها لاستثمار رحلات جينغ واستغلاها خير استغلال. ولانعدام وجود المنافس، تركز قلق أباطرة الصين بمخاوفهم من مدى زيادة النشاط التجاري لثراء جماعات لا تستهويهم كالتجار، بأكثر من التركيز على فرصة الاستئثار بثروات جديدة لأنفسهم (كحكام)؛ ولأن الدولة اتسمت بالقوة البالغة، تمكنوا من إخماد هذه الممارسة المنذرة بالخطر. ولذلك أصدروا في ثلاثينيات القرن الخامس عشر منعا للرحلات العابرة للمحيط، وأتلفوا ربما في السبعينيات من ذات القرن سجلات تشينغ، منهين بذلك حقبة عظيمة من الاستكشافات الصينية.
أما عالم الجغرافيا والأحياء جاريد دايموند فيقدم طرحا مماثلا في كتابه الكلاسيكي “مدافع وجراثيم وفولاذ”[12]. حيث تلخص هدفه بتفسير أسباب أسبقية الحضارات في المجتمعات التي تعيش ضمن خط العرض الذي يمتد من الصين وحتى البحر الأبيض المتوسط، لكنه أشار كذلك إلى أن أوروبا، وليس الصين، هيمنت على العالم الحديث لأن شبه الجزر الأوروبية مكّنت الممالك الصغيرة من تسهيل صمودهم أمام من يفترض أنهم الفاتحين الطبيعيين للعالم الجديد، وخلقت ميلا نحو التجزئة السياسية، في حين أن خط الساحل المستدير للصين مال مع الحكام المركزيين لا مع الأمراء الهامشيين. فسمحت الوحدة السياسية الناتجة عن هذا الوضع للأباطرة الصينيين بحظر الرحلات البحرية كرحلات تشينغ.
على النقيض من ذلك، وعلى الرغم من أنه كان في وسع ملكٍ إثر ملك في أوروبا المجزّأة رفض عرض كولمبوس المجنون، إلا أنه دائما ما استطاع أن يجد ملكا آخر ليقدم له عرضه. ولنا أن نتكهن لو توفرت لتشينغ خيارات متعددة لكان هيرنان كورتيس قد قابل حاكما صينيا في المكسيك سنة 1519، وليس (حاكم الآزتيك) الهالك مونتيزما. لكن طبقا لنظريات الحتمية بعيدة المدى، فإن قوى مجرّدة واسعة كالأمراض والديموغرافيا والجغرافيا أخرجت هذا الاحتمال من المعادلة.
بيد أن رحلات تشينغ وحقائق أخرى كثيرة أخذت مؤخرا تذهل بعض الناس للصعوبة المطلقة بمواءمتها لنماذج المدى البعيد. فقد برهنت اليابان بالفعل سنة 1905 أن الأمم الشرقية قادرة على مضاهاة قوة الأوروبيين في ساحات المعارك بهزيمتها الإمبراطورية الروسية. أما في سنة 1942، كادت اليابان أن تكتسح القوى الغربية وتطردها من المحيط الهادئ جميعا. ثم أنها عادت من رماد هزيمة مدمّرة سنة 1945 وغيّرت وجهتها لتصبح عملاقا إقتصاديا. وكما نعلم جميعا، اتخذت الصين منذ سنة 1978 مسارا مماثلا فتفوّقت سنة 2006 على الولايات المتحدة بتبوأها الصدارة كأكبر باعث للكربون في العالم، وحافظ الاقتصاد الصيني حتى في أحلك أيام الأزمة المالية 2008-2009 على معدلات نمو تحسدها عليها الحكومات الغرببية في أفضل أعوامها وأحوالها. ربما يتعيّن علينا أن نطرح جانبا السؤال القديم ونسأل سؤالا جديدا: ليس لماذا يهيمن الغرب، بل ما إذا الغرب يهيمن حقا؟ فإذا كانت الإجابة “لا”، فإن نظريات الحتمية بعيدة المدى التي تسعى لتفسيرات قديمة لهيمنةٍ غربيةٍ، لا توجد أصلا، تبدو عديمة الجدوى بلا ريب.
ثمّة ناتج تمخّض عن هذه الشبهات والإشكاليات ألا وهو أن بعض المؤرخين الغربيين طوّروا نظرية جديدة كاملة تفسر أسباب هيمنة الغرب وانحسارها حاليا. أُطلقُ عليها نموذج الصدفة قصيرة المدى. وتنحو حجج النظريات قصيرة المدى لأن تكون معقدة أكثر من نظيرتها بعيدة المدى، كما أن ثمة خلافات حادة تظهر بين أعضاء معسكرها. غير أن شيئا واحدا يجتمع عليه قصيرو المدى ويتفقون، وهو أن كل شيء تقريبا يقوله بعيدو المدى خاطئ. فهيمنة الغرب العالمية لم تتحتم منذ القدم؛ بل فقط بعد سنة 1800، عشية حرب الأفيون، حيث سحب الغرب البساط مؤقتا من أقدام الشرق، وحتى ذلك جاء بمحض مصادفةٍ كبرى. أما قصة ألبيرت في بكين (التخيّلية) فهي أبعد ما تكون عن السخافة، إذ كان يمكن لها أن تتحقق بسهولة.
الحظ العظيم

تشتهر مقاطعة أورانج في كاليفورنيا بسياساتها المحافظة وأشجار نخيلها المشذّبة، وكذلك (بالممثل) جون واين الذي أقام فيها مدة طويلة (سُمّي مطار المدينة المحلي على اسمه بالرغم من كرهه لتحليق الطائرات فوق ملعب الغولف)، بأكثر مما تشتهر بمنحاتها الدراسية الصارمة، لكنها أصبحت في تسعينيات القرن العشرين بؤرة لنظريات الصدفة قصيرة المدى لتاريخ العالم. فقد ألّف مؤرّخان (بين وونغ وكينيث بوميرانز) وعالم إجتماع (وانغ فينغ) كتبا في مقر حرم إيرفين[13] بجامعة كاليفورنيا أحدثت علامات تحول بارزة طرحوا من خلالها أنه مهما أمعنا النظر إلى –المحيط أو التكوين الأسري، أو التقنيات والصناعة أو المال والمال، ومستويات المعيشة أو أذواق المستهلكين- فإن أوجه التشابه بين الشرق والغرب رجَحت على أوجه الاختلاف رجحانا شاسعا منذ أواخر القرن التاسع عشر.
لو حالفهم الصواب في منظورهم هذا، فسنواجه –فجأةً- صعوبة أكبر في تفسير سبب مجيء لوتي إلى لندن بدلا من توجّه ألبيرت شرقا. جادل بعض من أتباع النظرية قصيرة المدى، كعالم الإقتصاد المنشق أندريه غاندر فرانك (الذي كتب أكثر من 30 كتابا حول كل شيء بدءا من ما قبل التاريخ ووصولا إلى التمويل في أمريكا اللاتينية)، أن الشرق تميز بموضع أفضل من الغرب لتحقيق ثورةٍ صناعيةٍ إلى أن تدخّلت المصادفات. فاستنتج فرانك أن أوروبا ببساطة ما هي إلا “شبه جزيرة هامشية نائية”[14] تقع في “نظام عالمي محوره الثقافة الصينية”. وقد حاول الأوروبيون، المستميتون بإيجاد منفذ نحو الأسواق الآسيوية، حيث الثراء الحقيقي، شق طريقهم بصعوبة إلى الشرق الأوسط من خلال الحروب الصليبية. وعندما لم يجدِ هذا نفعا، حاول بعضهم مثل كولمبوس الإبحار غربا أملا في الوصول إلى كاثاي[15].
غير أن ذلك كان مصيره الفشل أيضا، لأن أمريكا موجودة في منتصف الطريق. لكن، حسب وجهة نظر فرانك، رَسَم خطأ كولمبوس الفادح بداية التغيير لموقع أوروبا في النظام العالمي. في القرن السادس عشر ازدهر إقتصاد الصين لكنه واجه نقصا مستمرا بالفضة. أما أمريكا فامتلأت بالفضة؛ لذا استجابت أوروبا لحاجات الصين منها عبر جعل السكان الأصليين في أمريكا يحفرون لاستخراج ما لا يقل عن 150 ألف طن من هذا المعدن الباهظ من جبال البيرو والمكسيك ليذهب ثلثه إلى الصين. وبذلك، فإن الغرب، ومن خلال الفضة والوحشية والرقيق، حجز “مقعدا من الدرجة الثالثة في قطار الإقتصاد الآسيوي” كما يصف فرانك، لكن مازال ثمة حاجة لمزيد من الأحداث قبل أن يتمكن الغرب من “إزاحة الآسيويين من القطار برمته.”
يعتقد أندريه غاندر فرانك في كتابه المذكور سالفا أن نهوض الغرب أساسا لا يدين سوى بالقليل لحس المبادرة الأوروبية إذا ما قورن “باضمحلال الشرق” بعد سنة 1750.. فهو يجزم أن هذا الاضمحلال قد بدأ عندما أخذت موارد الفضة بالتضاؤل. وهو ما فجّر عددا من القلاقل السياسية في آسيا، لكنه بذات الوقت وفّر حافزا منشطا في أوروبا، حيث حرّك الأوروبيون مصانعهم، بعد تضاؤل تصدير الفضة لصنع بضائع تحل محلها في الأسواق التنافسية الآسيوية. وكان للنمو السكاني بعد سنة 1750 أيضا نتائج متباينة في طرفي المعادلة الأورو-آسيوية، كما يجادل فرانك، كعوامل استقطاب الثروة، وتغذية الأزمات السياسية، وإجهاض الابتكار في الصين، لكنه كذلك وفر أيدٍ عاملة رخيصة للمصانع الجديدة في بريطانيا. ومع استمرار تمزّق الشرق، حظى الغرب بميزة الثروة الصناعية التي وجب، وبكل استحقاق، أن تحدث في الصين؛ بيد أن حدوثها في بريطانيا أدى لأن يرث الغرب العالم.
على أن مؤيدين آخرين للنظرية قصيرة المدى لا يتفقون مع ذلك الرأي. فقد جادل جاك غلادستون (الذي درّس في جامعة كاليفورنيا وفي حرم ديفيس الجامعي عددا من السنوات، وصاغ مصطلح “مذهب كاليفورنيا التاريخي”[16] لوصف منظري النظرية قصيرة المدى) أن الشرق والغرب حتى سنة 1600 أخذا مكانهما المناسب على وجه التقريب (أو برداءة)، فقد حكمت فيهما إمبراطوريات زراعية عظمى بما فيهما من تقاليد كَنَسية عريقة ومصونة ومعقدة. وقد أودت الأوبئة والحروب وخلع العائلات الحاكمة، في كلّ مكان من إنجلترا وحتى الصين، بتلك المجتمعات إلى حافة الانهيار في القرن السابع عشر، لكن بينما استعادت معظم الإمبراطوريات عقائدها التقليدية وفرضتها مجددا بصرامة، كَفَرَت منطقة شمال غرب أوروبا بالتقاليد الكاثوليكية.
ويشير غلادستون إلى أن إرادة وفعل التحدي هي التي سارت بالغرب نحو طريق الثورة الصناعية. فإثر تحرر العلماء الأوروبيين من أغلال الآيديولوجيات البالية، نجحوا بكشف النقاب عن تشغيل مخرجات الطبيعة واستغلالها بفعالية عالية، ما جعل أصحاب العمل والتجار البريطانيين، الذين يتشاركون بهذه الثقافة النفعية الدؤوبة، يتعلمون كيفية استثمار الفحم والبخار والعمل من خلالهما. ومع حلول سنة 1800، كان للغرب السبق على بقية العالم سبقا حاسما.

يجادل غلادستون أن أيا من ذلك لم يكن حتميا والحقيقة التي تفرض ذاتها أن بضع حوادث بعينها أمكنها تغيير العالم تماما. فعلى سبيل المثال، اخترقت طلقة بندقية كاثوليكية في معركة بوين سنة 1690 كتف المعطف الذي ارتداه وليام أورانج، المطالب البروتستانتي بعرش إنجلترا. ويُفترض أن وليام قال: “مضت بسلام[17]، لم تقترب من مقتلي،” فيقول غلادستون لنا أن نتكهن لو أن الطلقة جاءت أسفل بسنتمترات قليلة لظلت إنجلترا كاثوليكية ولهيمنت فرنسا على أوروبا ولَمَا حدثت الثورة الصناعية.
أما كينيث بومرانز، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا إيرفينغ، فيمضي إلى ما هو أبعد من ذلك. فهو يرى أن نشوء الثورة الصناعية ما هو أصلا إلا ضرب من ضروب الحظ العظمى. فهو يرى أنه مع حلول سنة 1750 اتجه الشرق والغرب معا نحو كارثة بيئية، فتعداد السكان أخذ بالنمو على وتيرة أسرع من التقنيات المتاحة، وقد فعلت شعوبهما تقريبا كل ما يمكن فعله بشؤون توسعة الزراعة وتكثيفها، ونقل البضائع من مكان إلى آخر، وإعادة تنظيم أنفسهم. فأمسوا بذلك على شفا استنزاف المتاح لهم من تقنيات، مما جعل من كل أسباب توقع انتشار كساد عالمي وانحدار لتعداد السكان في القرنين التاسع عشر والعشرين وجيهة.
بيد أن القرنين المنصرمين شهدا نموا إقتصاديا فاق كل ما سبقهما من قرون التاريخ أجمع. ويشرح بومرانز العلة في ذلك عبر كتابه الهام “الحيد العظيم”[18] من أن أوروبا الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، قد حالفها الحظ ليس إلا. وعلى غرار فرانك، يرى بومرانز أن بداية الغرب التي حالفها الحظ من خلال اكتشاف أمريكا بالمصادفة المحضة قد أسس لنظام تجاري منح الحوافز لتكوين إنتاج تصنيعي؛ لكنه، على خلاف فرانك، يشير إلى أنه في وقت متأخر من سنة 1800 أخذت حظوظ أوروبا تنحو باتجاه الضمور والتضاؤل. لقد تطلب زرع أشجار كافية لحاجات بريطانيا من محركات البخار الخام البدائية، كما يشرح بومرانز، مساحات شاسعة من الأراضي فاقت المساحات التي امتلكتها أوروبا الغربية قاطبة. غير أن ضربة أخرى من ضربات الحظ أطلت برأسها: فبريطانيا لوحدها من بين جميع بقاع الدنيا اكتشفت مواقع لمناجم فحم ميسرة كما طوّرت من صناعاتها الميكانيكية بوتيرة سريعة. مع مطلع سنة 1840، كان البريطانيون يستعملون الآلات التي تشتغل بطاقة الفحم في كل مناحي الحياة، بما فيها السفن الحربية الفولاذية التي مكنتهم من شق طريقهم بالقوة إلى أعالي نهر يانغتزي. فتعيّن على بريطانيا حرق 15 مليون فدان من الغابات سنويا –وهو عدد غير متوفر من الفدادين- لكي تواكب الطاقة المستخرجة من الفحم. فبدأت ثورة الوقود الأحفوري، وأمكن تجنب كارثة بيئية (أو على الأقل تأجل وقوعها إلى القرن الواحد والعشرين)، فأصبح الغرب فجأة وعلى خلاف كل الاحتمالات مهيمنا على الكرة الأرضية. لم يكن ثمة حتمية في ذلك، كل ما في الأمر أنها مجرد مصادفة حديثة متقلّبة.
إن التباين بتفسيرات النظرية قصيرة المدى للثورة الصناعية الغربية، التي تمتد من حظ بومرانز الذي جنّب وقوع كارثة عالمية إلى تحوّلات فرانك المؤقتة ضمن الاقتصاد العالمي، شاسع في كل جزئياته إذا قارنّاه مثلا مع أطروحات جاريد دايموند وكارل ماكس، على جانب النظرية بعيدة المدى. على أن في خضم كل هذا الجدل المحتدم بين المدرستين، فإن حدود الخلاف الفاصلة بينهما هي التي تولّد أكثر النظريات المتعارضة تعارضا حادّا عن كيفية الطريقة التي يعمل بها العالم. ويزعم بعض أصحاب النظرية بعيدة المدى أن (المؤرخين) التنقيحيين ما هم إلا ذوي بضاعة رديئة ويعانون من عقدة الصواب السياسي والعلم الزائف، فرد بعض أصحاب النظرية قصيرة المدى أن أتباع بعيدة المدى تبريريون بموالاتهم للغرب، بل وعنصريون أيضا.
يشير الواقع الذي يتمخض عن مثل هذا الاختلاف الواسع الذي يمكن أن يبلغه كثير من الخبراء في استنباطاتهم إلى أن ثمة خطأ في الأسلوب الذي تعاملنا فيه مع تلك الإشكالية. وسأجادل في هذا الكتاب أن أصحاب النظريتين قصيرة المدى وبعيدة المدى على حد سواء قد أساءا فهم شكل التاريخ، وبالتالي لم يصلا سوى إلى استنباطات جزئية ومتناقضة. وأجزم أننا بحاجة إلى منظور مختلف.
شكل التاريخ
ما أعنيه بهذا أن أتباع النظريتين قصيرة المدى وبعيدة المدى يتفقان على أن الغرب قد هيمن على العالم بالقرنين المنصرمين، لكنهما يختلفان على ماهية ما كان عليها العالم قبل ذلك. فكل شيء يدور حول تقديراتهم المختلفة عن التاريخ ما قبل الحديث. أما الطريقة الوحيدة التي نحلّ من خلالها هذا النزاع تتركز بالنظر إلى تلك الحقب المبكرة لإرساء “شكل” مُجمل للتاريخ. حينها فقط يمكننا، بعد إرساء الأساس، أن نجادل بغزارة حول أسباب انتهاء الأمور إلى ما انتهت إليه.
إلا إن كلهم تقريبا اتفقوا كما يبدو على عدم فعل هذا الأمر. إن لمعظم الخبراء الذين يكتبون عن أسباب هيمنة الغرب خلفيات في علوم الإقتصاد أو الإجتماع أو السياسة أو التاريخ الحديث، فتخصصاتهم أساسا تنصبّ في الأحداث الراهنة أو الجارية مؤخرا، ويميلون نحو التركيز على الأجيال القليلة المنصرمة، فلا ينظرون للوراء سوى للخمسمائة سنة الماضية ويعالجون ما سبق ذلك من تاريخ بشيء من الإيجاز، إن تطرقوا إليه أصلا –حتى لو أن المسألة ذات الخلاف حول ما إذا كانت العوامل التي منحت السيطرة للغرب موجودة سلفا في الأزمان السابقة أو ظهرت بغتة في العصر الحديث.
لقد توجه إلى معالجة المسألة ذات الصلة قلّة قليلة من المؤرخين بطرق شديدة التباين مسلطين جلّ اهتمامهم على حقبة ما قبل التاريخ وقافزين منها إلى العصر الحديث. ولا يذكرون سوى قليلا عن آلاف السنين بين تلكما الفترتين. يسلط المؤرخ والجغرافي ألفريد كروسبي الضوء بلا تحفظ على ما يسلّم به هؤلاء العلماء- من أن ابتكار ما قبل التاريخ المتمثل بالزراعة له أهمية حاسمة، لكن ما بين تلك الحقبة[19] وزمن تطور المجتمعات التي أرسلت كولمبوس ورحّالة آخرين لعبور المحيطات، فترة تبلغ على وجه التقريب 4 آلاف سنة، لم يقع أثناءها أحداث ذات أهمية تذكر، بالنسبة إلى ما مضى قبلها.
أظن أن هذا يشوبه الخطأ. لن نجد أجوبة إذا ما حصرنا بحثنا في ما قبل التاريخ أو الأوقات الحديثة (وأضيف هنا بعجالة أننا لن نجدها كذلك في حال قيدنا أنفسنا في الألفيات الأربع أو الخمس بينهما فقط). إن هذه المسألة تتطلب منا النظر إلى امتداد التاريخ البشري كقصة واحدة، مع تأسيس شكلها المجمل، قبل مناقشة السبب في اتخاذها ذلك الشكل. وهذا ما أحاول تقديمه في هذا الكتاب، حيث استحضر تطبيق مجموعة مختلفة إلى حد ما من المهارات لتدعيم هذا المسعى.
لقد تلقيتُ تعليمي كعالم آثار ومؤرخ في التاريخ القديم، وتخصصتُ في الدراسات الكلاسيكية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في الألفية الأولى قبل الميلاد. وعند بدء دراستي في جامعة برمنغهام في إنجلترا سنة 1978، بدا أن معظم من واجهتهم من علماء الدراسات الكلاسيكية يشعرون براحة تامة حيال النظرية بعيدة المدى وأن الثقافة الإغريقية القديمة التي نشأت قبل ألفي ونصف الألف سنة قد صاغت أسلوب حياة مميز للغرب. بل إن بعضهم (لاسيما القدماء منهم) يقول إن التقاليد الإغريقية بالمطلق جعلت من الغرب أفضل من بقية العالم.
حسب ما أتذكر، لم يكن أيا من ذلك ليصيبني بالذهول كونه يمثل مشكلة محددة، إلى أن بدأتُ في بحث التخرج في جامعة كامبردج في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بعملي على موضوع أصول دويلات المدن الإغريقية. وأخذني هذا من بين علماء آثار الأنثروبولوجيا إلى العمل على أنماط مماثلة لبقاع أخرى من العالم. وقد تهكموا علنا من الفكرة عتيقة الطراز القائلة بأن الثقافة الإغريقية تميزت بالتفرد ودشنت تقاليد عقلانية وديمقراطية مميزة. لقد تدبرتُ لعديد من السنوات، كغيري من غالب الناس، غرس فكرتين متناقضتين في رأسي، فمن جهة نما المجتمع الإغريقي بموازاة ذات الخطوط التي نمت من خلالها المجتمعات القديمة الأخرى، ومن جهة أخرى افتتح ذلك المجتمع مسارا غربيا مميزا.
أخذ فعل الموازنة بين الفكرتين ينحو إلى الصعوبة عندما توليتُ أول مناصبي الأكاديمية في جامعة شيكاغو سنة 1987، حيث شاركتُ في التدريس في برنامج تاريخ الحضارة الغربية الذي اشتهرت به تلك الجامعة، والذي تراوحت الحقب التي تناولها من أثينا القديمة إلى سقوط الشيوعية (مؤخرا). وقد اضطررتُ إلى أن أقرأ في تاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديث لأوروبا بجدية أكثر عن ذي قبل حتى أسبق تلاميذي ولو بيوم واحد، ولم يمكنني التغاضي عن ملاحظة أن مسائل الحرية والعقل والابتكار التي يفترض أن الإغريق قد خلّفوها وراءهم على فترات طويلة من الزمن لقيت توقيرا وإجلالا في النقض والانتهاك أكثر من الامتثال والالتزام. وجدتُ نفسي، وأنا أجتهد محاولا أن أجعل من هذا منطقيا، أنظر لشرائح تتسع أكثر فأكثر من الماضي البشري. وأصبتُ بالدهشة من مدى قوة النظائر والتماثلات بين التجربة الغربية الفريدة من نوعها وتاريخ أجزاء أخرى من العالم على رأسها الحضارات العظمى في الصين والهند وإيران.
لا يقاوم أكثر الأساتذة التذمر من المسؤوليات الإدارية الثقيلة، لكن مع انتقالي إلى جامعة ستانفورد سنة 1995 أدركتُ بسرعة أن أقسام مراكز خدمة المجتمع يمكن لها أن تكون طريقة ممتازة لاكتشاف ما يجري خارج مجالي المحدود. فتوليتُ منذ ذلك الحين إدارة مركز الدراسات الأثرية ومؤسسة علم التاريخ الإجتماعي التابعين للجامعة، وأشرفتُ على عمليات تنقيب أثرية كبرى- ما يعني عددا لا يحصى من الأعمال المكتبية ووجع الرأس، لكن ذلك أيضا سمح لي بمقابلة متخصصين من شتى المجالات، بدءا من علم الوراثة وانتهاء بالنقد الأدبي، وهو ما قد يرتبط باستنباط أسباب الهيمنة الغربية.
لقد تعلمتُ شيئا مهما للغاية: لكي نحل هذه المسألة نحتاج إلى منهج موسّع يدمج بين تركيز المؤرخ على السياق، ووعي عالم الآثار بالماضي السحيق، وطرق عالم الإجتماع المقارَنة. أمكننا الحصول على هذا الدمج من خلال تأليف فريق متعدد الاختصاصات من الخبراء، جامعين بذلك خبرات عميقة من شتى المجالات، وهذا في الواقع ما فعلته بالضبط عند بدء إشرافي على عمليات تنقيب أثرية في مدينة صقلية. لم أمتلك معرفة تذكر عن علم النبات لكي أحلل البذور الكربونية التي وجدناها، أو عن علم الحيوان حتى أتعرف على عظام الحيوانات، أو عن الكيمياء لأفهم معنى رواسب أوعية التخزين، أو عن الجغرافيا لأعيد بناء عمليات تشكيل تنسيق المواقع، أو أن أصبح مستضيفا لتخصصات لا غنى عنها، ولذلك وجدتُ متخصصين ينجزون كل ذلك. فمشرف عمليات التنقيب يقترب عمله ليغدو كنشاط مدير فني أكاديمي يوفق بين فنانين موهوبين ليقدموا عرضا مسرحيا أو تلفازيا.
تعدّ هذه طريقة جيدة لإنتاج تقرير في التنقيب حيث يتركز الهدف بتجميع بيانات يستخدمها آخرون، لكن الكتب ذات الجهود والمساهمات الجماعية تنحو لأن تكون بجودة أقل لاسيما فيما يتعلق بإعداد حلول موحّدة لمسائل كبرى. فأتبنى في هذا الكتاب الذي بين أيدي القرّاء نهجا مشتركا يربط بين التخصصات عوضا عن النهج ذي المجالات والاختصاصات المتعددة. (وإن جاز لي التشبيه) بدلا من الجلوس بجانب السائق لقيادة حشد من الاختصاصيين، أنطلق وحدي بحرية لربط النتائج التي توصّل إليها خبراء المجالات المتعددة وتفسيرها.
لعل هذا يستدعي جميع أنواع المحاذير (كالسطحية، والتحيّز الجزائي، والهفوات العامة). لن أمتلك ذلك الوعي الرفيع في الثقافة الصينية كالشخص الذي أفنى عمره بقراءة مخطوطات القرون الوسطى، ولا أن أكون مواكبا لأحدث المعلومات في التطور البشري كعالم الوراثيات (قيل لي إن مجلة العلوم “ساينس” تحدّث موقعها الإليكتروني كل ثلاثين ثانية؛ وبينما أطبع هذه الجملة لابد أنني عدتُ للتخلف عنها مرة أخرى). لكن من جهة أخرى، فإن أولئك الذين يكتفون بالبقاء ضمن حدود منهجهم وتخصصهم لن يتسنى لهم رؤية الصورة الأشمل. فنموذج الكاتب الأحادي متعدد الاختصاصات غالبا ما يُعد الأسلوب الأسوأ لكتابة كتاب كهذا-من بين جميع الأساليب الأخرى. ويبدو بالنسبة إليّ أنه قطعا أقل الأساليب سوءا للمضي قدما، لكن عليكم أن تحكموا من خلال النتائج والبراهين ما إذا حالفني الصواب.
إذًا، ما هي هذه النتائج؟ أجادل في هذا الكتاب أن الهيمنة الغربية وأسبابها هي في حقيقتها مسألة تتعلق بما أطلق عليه التطوّر الاجتماعي. وأعني أساسا بهذا قدرة المجتمعات على إحداث الإنجازات تؤدي إلى تشكيل بيئاتها الثقافية والاجتماعية والمادية والاقتصادية وصولا نحو غاياتها الخاصة بها. فقد سلّم أغلب المراقبين الغربيين جدلا منذ القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين أن التطور الاجتماعي اتسم بالصلاح والخير دون أدنى شك. فقد ذكروا تلميحا وتصريحا في أحيان كثيرة أن التطور هو عملية تقدم (أو نمو، أو تاريخ)، وأن التطور –سواء نحو الرب، أو الرفاهية أو الفردوس البشري- ما هو إلا تجسيد لمغزى الحياة ومعناها. أما في أيامنا الحالية فيبدو هذا أقل وضوحا. حيث يشعر كثير من الناس أن التدهور البيئي والحروب وانعدام المساواة وخيبة الأمل التي تعم بسبب التطور الاجتماعي فاقت كثيرا أية منفعة يستحضرها.
بيد أنه مهما اشتدّت وطأة التهم الأخلاقية التي نلقيها على ظاهرة التطور الاجتماعي، يظل الواقع الذي يفرضها مفروغا منه. غدت جميع المجتمعات تقريبا في الوقت الراهن تتمتع بتطور أكبر (حسب معنى التطور الذي وضعت تعريفه لهذا المفهوم في الفقرة السالفة التي تحتها خط) من ذلك الذي عاشته في المائة سنة الماضية، وثمة مجتمعات حاليا أكثر تطورا من مجتمعات أخرى. ومما لا جدال فيه أنه مع حلول سنة 1842 كانت بريطانيا أكثر تطورا من الصين –بل تطور فاقها بمراحل في الواقع إلى درجة أن امتدادها أصبح عالميا. لقد ظهرت إمبراطوريات كثيرة في الماضي، لكن حيّز امتداداتها ظل إقليميا على الدوام. غير أنه مع حلول سنة 1842 تمكّن التجار البريطانيون من إغراق الصين ببضائعهم، وتمكّن المصنّعون البريطانيون من بناء سفن حديدية فاقت مدافعها كل سفن العالم الأخرى، وتمكن السياسيون البريطانيون من إيفاد بعثات تقطع المسافات والأشواط حتى نصف العالم.
إن السؤال عن أسباب الهيمنة الغربية يعني في حقيقته طرح سؤالين إثنين، حيث يتعين علينا معرفة:
أولا: لماذا الغرب أكثر تطورا من مناطق العالم الأخرى، و”تطورا” هنا بمعنى قدرته أكثر من غيره على إنجاز الأشياء.
ثانيا: لماذا ارتفع التطور الغربي ارتفاعا كبيرا خلال المائتي عاما المنصرمتين مما أدى لأن تهيمن قلة قليلة من البلدان على العالم بأسره لأول مرة في التاريخ.
أرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذين السؤالين تكمن في قياس التطور الاجتماعي وذلك لتكوين رسم بياني يعرض –حرفيا- شكل التاريخ. فما إن ننفذ هذا الرسم، سنرى أن لا النظرية الحتمية بعيدة المدى ولا نظرية الصدفة قصيرة المدى قادرتان على تفسير شكل التاريخ جملة وتفصيلا. أما الإجابة على السؤال الأول –لماذا التطور الاجتماعي الغربي أعلى من أي نظير له في أجزاء العالم الأخرى- فلا يظهر في أي حدث وقع مؤخرا: لقد ظل الغرب المنطقة الأكثر تطورا خلال الأربع عشرة ألفية من الألفيات الخمس عشرة الأخيرة. لكن من جهة أخرى، لم يحدث أيٌ من ذلك السبق الغربي بسبب الحتمية في الماضي البعيد. فقد سجلت الأقاليم الشرقية نقاطا أكثر لمدة تزيد على الألف عام بدءا من سنة 550 إلى 1775 للميلاد. فالهيمنة الغربية لم تكن مقدّرة سلفا لآلاف السنين، ولم تقع نتيجة لأحداث تصادفت مؤخرا.
من جانب آخر، لا تستطيع النظريتان بعيدة المدى أو قصيرة المدى من تلقائهما حل السؤال الثاني، وهو لماذا ارتفع التطور الاجتماعي الغربي بشدة مقارنة بجميع المجتمعات السابقة. فكما سنرى، أنه بدأت النقاط الغربية فقط عند سنة 1800 بالاندفاع السريع نحو القمة بمعدلات مذهلة؛ لكن هذه الطفرة بحد ذاتها لم تكن سوى نموذجا متأخرا لنمط ذي مدى طويل جدا من عملية تطور اجتماعي تتصف بتسارع مستقر المسار. هنا يعمل المديان البعيد والقصير معا.
فنستنبط لهذا السبب عدم مقدرتنا على تفسير الهيمنة الغربية إذا اكتفينا بالنظر فقط إلى ما قبل التاريخ أو النظر فقط إلى القرون القليلة السابقة. فلكي نجيب على السؤال علينا أن ندرك المراد من امتداد حركة الماضي ككل. ومع أن الرسوم البيانية لظواهر ارتفاع التطور الاجتماعي وهبوطه تكشف شكل التاريخ وتعرض لنا ما يتعيّن تفسيره، إلا إنها لا تقوم فعليا بعملية التفسير ذاته. ولتحقيق ذلك علينا أن نغوص في التفاصيل.
الكسل والخوف والطمع
“التاريخ (اسم): أخبار، معظمها زائفة، لأحداث، معظمها غير هامة، يفعلها حكّام، معظمهم أوغاد، وجنود معظمهم حمقى”<sup>[20]</sup> يصعب أحيانا الاعتراض على هذا التعريف الهزلي الذي ابتكره أمبروز بيرس: فالتاريخ يمكن له أن يكون حدثا ملعونا بعد آخر، خليط فوضوي من المبدعين والبلهاء، والطغاة والرومانطيقيين، والشعراء واللصوص، يحققون الأمور الرائعة أو ينحدرون نحو الرذيلة.
سيرصّع مثل هؤلاء الناس الصفحات التالية في هذا الكتاب، وهو ما يجب أن يكون. فمن يقوم بكل مظاهر الحياة والموت والإبداع والصراع في هذا العالم هم بالنهاية هؤلاء الأفراد الذين هم من لحم ودم، ولا يضطلع بذلك القوى الشاسعة غير الإنسانية. غير أنني وراء كل هذه الجعجعة بلا طحين، سأجادل أن للماضي بالرغم من ذلك أنماطا قوية، وباستطاعة المؤرخين، باستخدام الأدوات الصحيحة، ألا يكتفوا بالنظر لماهيتها فحسب، بل ويفسرونها أيضا.
سأستخدم ثلاثا من هذه الأدوات.
أولهما علم الأحياء[21] الذي يكشف لنا النقاب عن ماهية البشر الحقيقية: فصيل شمبانزيات ذكية. إننا جزء من مملكة الحيوان، التي هي بدورها جزء من إمبراطورية الحياة الأكبر، والتي تمتد من القردة العظمى وحتى الأميبات وحيدة الخلية. ولهذه الحقيقة الجليّة ثلاثة مآلات هامة.
الأولى، أننا نعيش، مثلنا مثل كل الأشكال الحية، لأننا نستخرج الطاقة من بيئتنا ونحول هذه الطاقة إلى مزيد من أنفسنا (التكاثر).
الثانية، أننا مخلوقات فضولية، على غرار كل الحيوانات الأكثر ذكاء. فنحن باستمرار نصلح الأشياء ونرقّعها ونتساءل ما إذا هي جيدة للاستخدام أو يمكننا الاستمتاع بها أو تحسينها. فنحن لا نتميز عن الحيوانات الأخرى سوى بتصليح الأشياء وترقيعها، لأننا نمتلك أدمغة كبيرة وسريعة تحتوي على طيّات دماغية كثيرة تسمح لنا بالتفكير في الأمور مليًا، وتليّن الحبال الصوتية إلى ما لا نهاية لكي نشرح الأشياء صوتيا، وأصابع إبهام تجعلنا نعمل على الأشياء بكفاءة.
على الرغم من ذلك، من الواضح أن البشر –على غرار الحيوانات الأخرى- ليسوا متشابهين جميعا. فبعضهم يستخرج من البيئة طاقة أكثر من غيرهم، وبعضهم الآخر يتكاثر أكثر من البقية، وبعضهم الآخر يتمتع بفضول وإبداع وذكاء أكثر، أو يتصف بالجانب العملي أكثر من غيره. لكن المآل الثالث لحيوانيتنا أن المجاميع البشرية الضخمة، على خلاف البشر الفرادى، يتسمون جميعا بقدر كبير من التشابه. لو أخذنا شخصين عشوائيين من جماعة كبيرة، فلأحدنا أن يتصور أنهما مختلفان كما يشاء، لكننا لو جمعنا مجموعتين كاملتين من الناس فسيميلون نحو مواصفات شديدة التطابق بين بعضهما بعضا. وإذا قارن المرء بين ملايين المجموعات بإحكام وثبات، كما فعلتُ في هذا الكتاب، فسيغلب عليهم امتلاك مقادير شديدة التشابه من الأشخاص ذوي الحيوية والخصوبة والفضول والإبداع والذكاء والهذر والجانب العملي.
تبدو تلك المآلات الثلاث كملاحظات منطقية ومعقولة تفسر، على نحو معين، قدرا كبيرا من مسار التاريخ. لقد ظل التطور الاجتماعي لآلاف السنين يزداد عموما بفضل تصليحاتنا وترقيعاتنا، وبقي يعمل على هذه الوتيرة عموما بمعدل متسارع. تلد الأفكار الجيدة مزيدا من الأفكار الجيدة، وإذ كان بحوزتنا ذات مرة أفكارا جيدة فنحن نميل لنسيانها. لكن كما سنرى، علم الأحياء لا يشرح مجمل تاريخ التطور الاجتماعي الذي يبقى أحيانا في حالة ركود لفترات طويلة دون صعود البتة؛ بل يأخذ أحيانا مسار الاتجاه المعاكس. لا يكفي أن نعرف أننا من الشمبانزيات الذكية فحسب.
هنا يأتي دور الأداة الثانية ألا وهي العلوم الاجتماعية[22]. تكشف لنا العلوم الاجتماعية مسببات التغيير الاجتماعي وكذلك ما يسببه التغيير الاجتماعي في آن واحد. فثمة أمران مختلفان تماما ولابد من التفريق بينهما: الأول أن يجلس شمبانزي ذكي ليعدل من الأشياء ويصلحها، والثاني أن يعمل على نشر أفكاره وإحداث التغيير في المجتمع. فهذا يتطلب نوعا من أنواع الحوافز، كما يبدو. أشار ذات يوم مؤلف الخيال العلمي الرائع روبرت هاينلين أن “التقدم يضطلع به رجال كسولين يسعون نحو أسهل الوسائل لإنجاز الأمور.”[23] سنرى لاحقا في هذا الكتاب أن نظرية هاينلين صحيحة جزئيا فقط، لأن النساء الكَسْلى يمثلن أهمية مماثلة للرجال الكسالى، ولا يُعد الكسل الدافع الوحيد للاختراع، و”التقدم” هي كلمة مستبشرة لما سيحدث. لكن إذا شرّحناها قليلا، أعتقد أن مقولة هاينلين الحكيمة تمثل جملة اختزالية جيدة لمسببات التغيير الاجتماعي كما سنكتشف غالبا. الحقيقة أنني مع مضي الكتاب قدما سأنتحل نسخة أقل منها لأكوّن نظرية موريس الخاصة بي والقائلة: “التغيير يسببه أناس كسالى وجشعون وخائفون، وهم يبحثون عن طرق سهلة وأكثر ربحا وأمنا لإنجاز الأشياء. ونادرا ما يكونون على دراية بما يقومون به.” يعلمنا التاريخ أن عند وقوع الضغط، ينطلق التغيير.
يسعى الخائفون والكسالى والجشعون بحثا عن توازنهم المفضل بين الشعور بالراحة والأمان وبذل أقل عمل ممكن. لكن هذه ليست نهاية القصة، لأن نجاح الناس بالتكاثر والاستحواذ على الطاقة يضع لا محالة ضغطا على الموارد المتوفرة أمامهم (سواء الاجتماعية والفكرية منها بالإضافة إلى الموارد المادية). إن التطور الاجتماعي المتصاعد يولّد ذات القوى التي تقوّض توطيد التطور الاجتماعي. وأطلق على هذا نقيض التطور. فالنجاح يخلق مشاكل جديدة؛ وحلها ما ينفك عن خلق مشاكل جديدة أخرى. وما الحياة إلا وادٍ للدموع، كما يقولون.
إن نقيض التطور يعمل عمله باستمرار، فيعترض الناس بخيارات عصيبة. وغالبا ما يفشل الناس بمواجهة تحدياته، فيتعرّض التطور الاجتماعي إلى الركود، بل وإلى الاضمحلال كذلك. إلا أن في أوقات أخرى يجتمع الكسل والخوف والطمع ليدفعوا بعضا من الناس للإقدام على مجازفات كبيرة، فيبتكرون ما يغيّر قواعد اللعبة. فإذا نجح قلة منهم على الأقل وتبنى معظم الناس لاحقا الابتكارات الناجحة، فإن المجتمع قد يدفع نحو استغلال المصادر المتاحة عن آخرها فيحافظ التطور الاجتماعي بذلك على ارتفاعه.
يواجه الناس مثل هذه المشاكل ويحلّونها يوميا، وهذا ما يفسر سبب استمرار التطور الاجتماعي في الصعود بوجه عام منذ نهاية آخر عصر جليدي. لكن كما سنرى، يخلق نقيض التطور في مراحل معينة حدودا قصوى صلبة لا تلين سوى لتغيّرات وتحوّلات جذرية. يثبُت التطور الاجتماعي عند هذه الحدود مفجرا بذلك سباقا مستميتا من التدهور. سنرى في حالة إثر أخرى أن المجتمعات عندما تفشل بحل المشاكل التي تعترضها، فإن حزمة رهيبة من البلاءات -كالمجاعات والأوبئة والهجرة غير المنضبطة وفشل الدولة- تبدأ بإصابتهم، محوّلة بذلك الركود إلى حالة انحدار؛ وعندما يضاف للمجاعة والأوبئة والهجرة وفشل الدولة قوى مزعزعة أخرى مثل التغيير المناخي (أطلق على هذه المظاهر الخمسة مجتمعةً “فرسان الهاوية”)، يتحول الانحدار إلى انهيارات كارثية تمتد إلى قرون وعصور ظلام طويلة.
إن علما الأحياء والاجتماع يفسران ما بينهما معظم شكل التاريخ –سبب قيام التطور الاجتماعي عموما، وسبب قيامه بوتيرة أسرع في بعض الأوقات ووتيرة أبطأ في أوقات أخرى، وسبب سقوطه في بعض الأحيان. لكن هذه القوانين البيلوجية والسسيولوجية تتسم بأنها عوامل ثابتة تنطبق في كل مكان وفي جميع الأزمان. فهي حسب تعريفها تخبرنا عن البشرية بالمجمل، ولا تطلعنا على سبب تدبر الناس أمورهم في مكان معين بأسلوب مختلف عن غيرهم في مكان آخر. ولكي نشرح ذاك، سأناقش في هذا الكتاب أننا بحاجة إلى أداة ثالثة: الجغرافيا[24].
الموقع، الموقع، الموقع
علق الفنان الفكاهي إدموند بينتلي في سنة 1905 قائلا “إن فن السيرة يختلف عن الجغرافيا؛ فالسّيَر تروي حكايات الرجال والأبطال، أما الجغرافيا فتصف الخرائط والجبال”[25]. هيمن لسنوات طوال الرجال والأبطال –حسب إدراك رجال الطبقة الراقية في بريطانيا- على الحكايات التي رواها المؤرخين إلى الحد الذي لا يكاد فيه أحد يميّز التاريخ عن السيرة. وقد تغيّر ذلك في القرن العشرين مع إضافة المؤرخين للنساء ورجال الطبقة الدنيا والأطفال أبطالا فخريين كذلك إلى الجانب الذي يروونه من القصة، لكنني في هذا الكتاب أريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. فحال أن نتعرف على أن الرجال والأبطال (ضمن معنى المجاميع الضخمة وحسب المفهوم الجديد والأوسع للكلمة) يتسمون جميعا بالتشابه، فسأجادل أن الذي تبقى هو الخرائط.
يُبدي عديد من المؤرخين ردة فعل تشوبها الاستثارة والحنق تجاه هذا الزعم. فهنا يبرز أمران مختلفان تماما، الأول أن يرفضوا، كما قال لي عدد لا بأس به منهم، الفكرة القديمة القائلة بأن قلة من الرجال العظماء فرضوا أن التاريخ قد بانت ملامحه بطريقة مختلفة في كلّ من الشرق والغرب؛ والثاني القول إن الثقافة والقيم والاعتقادات لم تشكل أهمية تُذكر ويتعين البحث عن سبب الهيمنة الغربية كليًّا في القوى المادية العمياء. بيد أن هذا ما سأقترح فعله إلى حد بعيد أو قريب.
سأحاول أن أُظهر أن الشرق والغرب قد خاضا ذات المراحل من التطور الاجتماعي خلال الخمسة عشر ألف سنة السالفة، وفي ذات الترتيب، لأنهما مأهولتان بذات المجموعات من الكائنات البشرية التي تُحدِث ذات الأصناف من أنماط التاريخ. لكنني سأظهر أيضا أنهما لم ينجزا ذلك بذات الحقب الزمنية ولا بذات السرعة. سأختتم مستنتجا أن البيولوجيا والسسيولوجيا تشرحان أوجه الشبه العالمية، في حين أن الجغرافيا تشرح أوجه الاختلافات الأقليمية. وحسب هذا المعنى، فإن الجغرافيا هي التي تشرح أسباب الهيمنة الغربية.

فلنقلها بصراحة ووضوح، يبدو هذا كرأي متشدد ينتمي لنظرية الحتمية بعيدة المدى كما يمكن للمرء أن يتصور، ولا شك أن ثمة مؤرخين نظروا للجغرافيا بهذه الطريقة. يعود منبع هذه الفكرة إلى زمن هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو الشخصية التي أشار لها الإغريق على أنه مؤسس التاريخ. حيث يصرّ قائلا “إن البلدان الرخوة الضعيفة تنجب رجالا ضعفاء”، ثم يستنتج، على غرار سلسلة طويلة من الحتميين والجبريين منذ زمنه، أن الجغرافيا جعلت من العظمة قَدَرا لبلاده. ربما يعد نموذج إيلزوورث هانتينغتون الجغرافي في جامعة ييل المثال الأجدر بالملاحظة، حيث نسّق هذا الرجل مجموعات كبيرة من الإحصائيات لكي يبرهن على أن مسقط رأسه، مدينة نيو هافين في ولاية كونيكتيكت، حازت تقريبا على المناخ المثالي لتحفيز الناس على العظمة. (فقط إنجلترا كانت الأفضل). واستنتج على النقيض من ذلك أن مناخ كاليفورنيا –حيث أعيش- “حمل قدرا مبالغا به من التحفيز بانتظام”[26] ولم ينتج عنه سوى معدلات مرتفعة من الجنون. وأكد هانتنغتون للقراء أن “مَثَل أهل كاليفورنيا كمثل الخيول التي يُحمل عليها لأقصى حد فيُنهك بعضها قبل أوانه وبعضها الآخر ينهار.”
يسهُل السخرية على مثل هذا الأمر، لكن عندما أقول إن الجغرافيا تفسر أسباب هيمنة الغرب فإنني أفكر بشيء مختلف تماما. إن الاختلافات الجغرافية تمتلك فعلا بعضا من مؤثرات المدى البعيد، لكنها ليست حتمية بالمطلق، وما يُحسب كميزة جغرافية في مرحلة معينة من التطور الاجتماعي قد يكون غير ذي صلة أو عيبا إيجابيا في مرحلة أخرى. فلنا أن نقول طالما أن الجغرافيا تقود التطور الاجتماعي، فإن التطور الاجتماعي يفرض ما تعنيه الجغرافيا. فهو أشبه بشارع مكوّن من اتجاهين.
حتى أشرح هذا الأمر بأسلوب أفضل نوعا ما –ولكي أقدّم خارطة طريق موجزة لبقية الكتاب- فإنني أود إلقاء نظرة على عشرين ألف سنة إلى الوراء، حيث الفترة الأكثر برودة في آخر العصر الجليدي. فقد مثلت الجغرافيا آنذاك أهمية قصوى: غطت الكتل الجليدية ذات الكثافة التي تبلغ ميلا لكل منها النصف الشمالي للكرة الأرضية، وأحاطتها السهول الجليدية الجرداء وشبه المعدومة من السكان، وتعذّرت سبل الحياة إلا قرب خط الاستواء حيث عاشت زمرٌ صغيرة من البشر على الصيد والجمع. لقد بلغت الفروقات بين الجنوب (حيث يمكن للناس أن تعيش) والشمال (حيث لا يمكنهم ذلك) إلى مداها الأقصى، لكن الفوارق داخل المنطقة الجنوبية كانت صغيرة نسبيا.
لقد غيّرت نهاية العصر الجليدي معنى الجغرافيا ومفهومها. فقد ظل القطبان باردين وبقي خط الاستواء ساخنا، بطبيعة الحال، لكن في ست من الأماكن الإثنا عشرة بين هذين الطرفين –وهو ما سأطلق عليه في الفصل الثاني المحاور الأصلية- اتجه الطقس الدافئ بالتضامن مع الجغرافيا المحلية نحو ترجيح كفة تطور النباتات و/أو الحيوانات التي يمكن للبشر ترويضها واستئناسها (أي أنها أصبحت معدّلة وراثيا لجعلها أكثر نفعا، ولكي تصل في النهاية إلى النقطة التي لا تعيش فيها الكائنات الحية المعدلة وراثيا إلا بالتكافل البيولوجي مع البشر). وجود النباتات والحيوانات المستأنسة يعني مزيدا من الطعام، وهو ما يعني أناسا أكثر، وهو ما يعني مزيدا من الابتكارات؛ لكن هذا الاستئناس يعني أيضا مزيدا من الضغط على ذات الموارد التي قادت العملية برمتها. لقد بدأ عمل نقيض التطور فورا.

ظلت جميع هذه المناطق المحورية نموذجا مطابقا بعض الشيء للمناطق المأهولة والدافئة نسبيا أثناء العصر الجليدي، لكنها أصبحت الآن متمايزة تمايزا متزايدا عن بقية العالم من جهة وعن بعضها بعضا من جهة أخرى. وقد رجّحتها جميعا الجغرافيا، لكنها رجّحت بعضا منها أكثر من الأخرى. تميّز أحد هذه المحاور، ويطلق عليه منطقة الهلال الخصيب[27] الواقعة في أوراسيا الغربية، بتركيز كثيف وفريد من نوعه في النباتات والحيوانات المستأنسة؛ وبما أن المجاميع البشرية متشابهة بالمجمل، فقد بدأ تحديدا في هذا المكان، الذي اتسمت موارده بالثراء وعملية (تطوره) بالسلاسة، الانتقال نحو الاستئناس والتدجين. حدث ذلك حول سنة 9500 قبل الميلاد.
تبعا لما أرجو أنه إدراك عام، سأستخدم عبر ثنايا هذا الكتاب تعبير “الغرب” لوصف كل المجتمعات التي انحدرت من هذه المنطقة في أقصى الغرب (وما سبقها) ضمن المحاور الأوراسية. لقد توسّع الغرب منذ زمن طويل وامتد منطلقا من المحور الأصلي في جنوب غرب آسيا[28] ليحيط بحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، وكذلك بالأمريكيتيين وأستراليا أيضا في غضون القرون القليلة المنصرمة. وكما أرجو أنه سيمسي جليا، فإن لتعريف “الغرب” بهذه الصورة (بدلا من التعرّض لبعض القيم التي يفترض أنها “غربية” الطابع كالحرية والعقلانية والتسامح، ثم الجدل من أين نبعت وأي أجزاء العالم تتحلى بها) مآلات كبرى لفهم العالم الذي نعيش فيه. ويتركز مسعاي بتفسير سبب الهيمنة الآنية على العالم من قبل مجموعة محددة من المجتمعات تنحدر من المحور الغربي الأصلي –وعلى رأسها مجتمعات أمريكا الشمالية- بدلا من مجتمعات أخرى من بقاع العالم، أو مجتمعات انحدرت من أحد المحاور الأخرى، أو ربما بلا مجتمعات على الإطلاق.
سأستخدم تبعا لهذا المنطق تعبير “الشرق” للإشارة إلى تلك المجتمعات التي تنحدر من أقصى الشرق (وثاني أقدم) المحاور الأوراسية. فالشرق أيضا توسّع وامتد منذ زمن طويل انطلاقا من محوره الأصلي بين نهري الصين الأصفر ويانغتزي، حيث بدأ استئناس النباتات حول العام 7500 قبل الميلاد، ويمتد حاليا من اليابان شمالا إلى بلدان الهند الصينية جنوبا.
إن المجتمعات التي تنحدر من محاور أخرى –محور الجنوب الشرقي في غينيا الجديدة حاليا، ومحور الجنوب الآسيوي في باكستان وشمال الهند الحديثة، ومحور أفريقي في الصحراء الكبرى الشرقية، ومحوران للعالم الجديد في المكسيك وبيرو- جميعها تمتلك تواريخ حضارية خلابة، وسأذكرها بإيجاز وتكرار في الصفحات القادمة، لكنني سأركز بكل ما أوتيت من جهد على المقارنات بين الشرق والغرب. ويتمثل استدلالي في أن مجتمعات العالم الأكثر تطورا ومنذ نهاية آخر عصر جليدي كانت تقريبا دائما ضمن المجتمعات المنحدرة من المحورين الأصليين الشرقي أو الغربي. فبينما تشكّل حكاية ألبيرت في بكين بديلا مقنعا لواقع لوتي في بالمورال، فإن افتراض ألبيرت في كوزكو، أو في دلهي، أو في غينيا الجديدة ليس بديلا مقنعا البتة. أما الطريقة المثلى لتفسير أسباب الهيمنة الغربية فتتركز نتيجة لذلك على الانكباب على المقارنات بين الشرق والغرب، وهو ما فعلته في هذا الكتاب.
إن تأليف الكتاب بهذا الأسلوب له تكاليف عديدة. فسرد حكاية أكثر شمولا وإحكاما وتنظر إلى كل منطقة من مناطق العالم المختلفة سيسبغ عليها ثراء أكبر ودقة أكثر في عرض درجات الاختلاف، كما سيمنح ثقافات جنوب آسيا والأمريكيتين والمناطق الأخرى حقها الكامل في جميع إسهاماتها الحضارية. غير أن مثل هذه النسخة الشاملة قد تشوبها المثالب لاسيما في فقدان عنصر التركيز، وستتطلب صفحات أخرى كثيرة تزيد على ما كتبته في هذا الكتاب. لقد أبدى ذات مرة صامويل جونسون، الكاتب والأديب الإنجليزي حاد الذكاء في القرن الثامن عشر، تعليقا مفاده “ألا أحد من الناس يتمنى أن تطول القصيدة الملحمية الفردوس المفقود”[29] بأكثر مما هي عليه، طالما أعجبتهم جميعا. وأظن أن ما ينطبق على شاعرها جون ميلتون ينطبق بدرجة أكبر على أي شيء قد أقدمه هنا.
لو أن الجغرافيا تقدم تفسيرا حقيقيا للحتمية بعيدة المدى على الطراز الهيروديتي لكان باستطاعتي إنهاء الكتاب واختصاره بسرعة عبر لفت النظر إلى بدء الاستئناس في المحور الغربي عند سنة 9500 قبل الميلاد وفي المحور الشرقي حول سنة 7500 قبل الميلاد. ولظل التطور الاجتماعي الغربي ببساطة متقدما على نظيره الشرقي بألفي عام، ولخاض الغرب غمار الثورة الصناعية والشرق مازال يحاول اكتشاف الكتابة. لكن من الواضح أن ذلك لم يحصل على ذلك النحو. فكما سنطالع في الفصول اللاحقة في هذا الكتاب، لم تفرض الجغرافيا حتميةً على التاريخ، لأن المزايا التاريخية دائما ما تتصف نهاياتها بالنقض الذاتي. فهي تدفع التطور الاجتماعي قدما، لكن التطور الاجتماعي أثناء العملية يغير معنى الجغرافيا ومفهومها.
تتوسع المحاور مع ارتفاع مؤشرات التطور الاجتماعي، أحيانا عبر الهجرة وأحيانا أخرى عبر النسخ أو الابتكار المستقل على أيدي الجيران. وتنتشر التقنيات التي تجدي نفعا في المحور الأقدم –سواء تقنيات الزراعة والحياة القروية، أو المدن والدول، أو الإمبراطوريات العظمى، أو الصناعات الثقيلة- في المجتمعات الجديدة والبيئات الجديدة. ولقد ازدهرت بعض من هذه التقنيات تارة في المشهد الجديد؛ وتارة أخرى تستمر بعشوائية وكيفما اتفق؛ وتحتاج تارة ثالثة إلى تعديلات وتحسينات كبرى لكي تجدي نفعا.
على الرغم من أن التالي قد يبدو غريبا، إلا أن أكبر حركات التقدم في التطور الاجتماعي تأتي غالبا في أماكن حيث لا تنفع معها بفعالية طرق مستوردة أو منسوخة من محور أكثر تطورا. يقع هذا أحيانا لأن كفاح الناس بمواءمة الطرق القديمة على البيئات الجديدة يجبرهم على إنجاز الاختراقات؛ ويعود سبب هذا أحيانا إلى أن العوامل الجغرافية التي قد لا تشكّل أهمية تذكر في مرحلة معينة من التطور الاجتماعي، ستحتلّ أهمية كبرى في مرحلة أخرى.
قبل خمسة آلاف سنة، على سبيل المثال، مثّلت حقيقة أن البرتغال وأسبانيا وفرنسا وبريطانيا جزء أوروبي يتجه أكثر نحو المحيط الأطلسي نقيصة جغرافية ضخمة، ما يعني أن هذه الأقاليم كانت شديدة البعد عن مركز الأحداث الهامة في بلاد الرافدين[30] ومصر. إلا إن التطور الاجتماعي قد ارتفع قبل خمسمائة سنة إلى الحد الذي غيّر من معنى الجغرافيا. لقد ظهرت أنواع جديدة من السفن قادرة على عبور ما كان دوما المحيطات غير القابلة للاجتياز، وهو ما جعل الاتجاه نحو الأطلسي فجأةً ذا فائدة عظمى. فالذي بدأ الإبحار نحو الأمريكيتيين والصين واليابان هي السفن البرتغالية والأسبانية والفرنسية والإنجليزية، بدلا من المصرية والعراقية. والأوروبيون الغربيون هم من بدأوا ربط مسارات العالم بالتجارة البحرية، والتطور الاجتماعي لأوروبا الغربية حلّق عاليا متجاوزا المحور الأقدم الواقع في شرق المتوسط.
أطلق على هذا المظهر “مزايا التخلف”[31][32]، وهو مظهر قديم قِدَم التطور الاجتماعي ذاته. فعندما بدأت القرى الزراعية بالتحول إلى مدن (بعد وقت قصير من سنة 4000 ق.م. في الغرب و2000 ق.م. في الشرق). فقد أصبح الوصول إلى التربة والمناخات المناسبة التي رجّحت كفة النشأة الأولى للزراعة يأخذ أهمية أقل من الوصول إلى الأنهار الكبرى التي أمكن شق تفريعات منها لتروية الحقول أو أن تُستخدم كطرق تجارة بحرية. وإثر توسع الدول باضطراد، أمسى هدف الوصول إلى الأنهار الكبرى أهمية أقل عن العثور على المعادن، أو إلى طرق تجارية بحرية أطول، أو إلى مصادر للقوة البشرية. فالموارد التي يتطلبها التطور الاجتماعي تتغيّر كذلك بتغيّراته، والمناطق التي نُظر لها بقلة اهتمام قد تكتشف مزايا عديدة بتخلفها.
يصعب دائما أن نحدّد سلفا الكيفية التي ستنتهي عليها مزايا التخلف: فأشكال التخلف لا تتساوى. على سبيل المثال، بدا لكثير من الأوروبيين قبل أربعمائة سنة أن المزارع المزدهرة اقتصاديا في جزر الكاريبي لها مستقبل أكثر إشراقا من مزارع أمريكا الشمالية. وباستطاعتنا أن نلاحظ -بعد فوات الأوان- لماذا تحولت هاييتي إلى أفقر بقعة في نصف الكرة الغربي والولايات المتحدة إلى أغناها، لكن يصعب جدا التنبؤ بمثل هذه المحصلات.
على أن إحدى أكثر المآلات وضوحا هي تلك التي تجلّت بانتقال أكثر المناطق تطورا وتحركها ضمن كل محور من المحاور على مر الزمن. ففي الغرب، تحولت من منطقة الهلال الخصيب (في عصر أوائل الفلاحين) جنوبا نحو الوديان النهرية في بلاد الرافدين ومصر إثر نشوء الدول ومن ثم غربا نحو حوض البحر الأبيض المتوسط بعد أن أصبحت التجارة والإمبراطوريات تحتلّ أهمية أكبر. أما في الشرق فقد نزحت شمالا من المنطقة الواقعة بين نهري يانغتزي والأصفر ومرورا بحوض النهر الأصفر نفسه ثم نحو نهر واي ومنطقة تشين.
وبرز للعيان مآل ثان وتمثل في تأرجح سَبْق الغرب في التطور الاجتماعي وتذبذبه لسبب جزئي أول بتوزّع هذه الموارد الحيوية -كالنباتات البرية وحيواناتها، والأنهار، وطرق التجارة البحرية، والقوة البشرية- في طرق مختلفة عبر كل محور، ولسبب جزئي آخر تركّز في أن عمليتي التمدد ودمج الموارد الجديدة في كل من المحورين اتسما بالعنف وعدم الاستقرار، وهو ما دفع نقيض التطور إلى التسارع المفرط. وقد جعل نمو الدول الغربية في الألفية الثانية قبل الميلاد البحر الأبيض المتوسط ليس بمنزلة طريق سريع للتجارة فحسب، بل طريقا لقوى الاضطراب أيضا. لقد فقدت الدول الغربية عند حلول سنة 1200 قبل الميلاد السيطرة، ففجّر ظهور مشاكل الهجرات، وفشل الدول، والمجاعات، والأوبئة انهيارا محوريا واسع النطاق. أما الشرق، الذي لم يحتوِ على بحر داخلي، لم يعانِ مثل هذا الانهيار، ومع حلول سنة 1000 قبل الميلاد تقلص سبق الغرب في التطور الاجتماعي تقلصا حادا.
لقد انتهت ذات النمطية على مدار الثلاثة آلاف سنة اللاحقة إلى مآلات مستمرة التغيير مرارا وتكرارا. وفرضت الجغرافيا تحديد مواطن الارتفاع السريع للتطور الاجتماعي في العالم، لكن التطور الاجتماعي المرتفع بالمقابل غيّر معنى الجغرافيا. وقد حسمت في مراحل مختلفة السهوب العظمى الواصلة بين أوراسيا الشرقية والغربية، والأراضي الغنية بالأرز في جنوب الصين، والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي أهميتها البالغة كلاً على حدة؛ وعندما برزت مكانة المحيط الأطلسي الهامة في القرن السابع عشر، أنشأت هذه الشعوب التي تأهلت لأفضل وضعية لاستغلالها –البريطانيون في المقام الأول ثم من استعمروهم سابقا في أمريكا- جميع أنواع الإمبراطوريات والاقتصاديات وحرروا الطاقة الكامنة في الوقودات الأحفورية. وفي ذلك، سأدلل على برهاني لأسباب الهيمنة الغربية.
خطة الكتاب
لقد قسّمت الفصول التالية إلى ثلاثة أقسام. يتصدى القسم الأول (الفصول من 1 إلى 3) إلى المسائل الأساسية الأهم ألا وهي: ما هو الغرب؟ ومن أين نبدأ تاريخنا؟ وماذا نعني “بالهيمنة”؟ وكيف نميّز الذي يحكم أو يهيمن؟ في الفصل الأول، سأعرض الأسس البيولوجية للقصة في تطور البشرية الجديدة وانتشارها حول العالم؛ أما في الفصل الثاني، فسأقتفي أثر تكوين المحورين الأصليين الشرقي والغربي ونموهما بعد العصر الجليدي؛ ثم في الفصل الثالث، سأخرج عن سردية القصة لكي أعمل على تعريف التطور الاجتماعي وأشرح كيفية استخدامه لقياس الاختلافات بين الشرق والغرب.[33]
أما في القسم الثاني (الفصول من 4 إلى 10)، سأتتبع قصتيّ الشرق والغرب بالتفصيل، ومتساءلا باستمرار عما تفسره تشابهاتهما واختلافاتهما. ففي الفصل الرابع، سأراقب قيام أولى الدول والعراقيل الكبرى التي حطمت المحور الغربي على مر القرون حتى سنة 1200 قبل الميلاد. أما في الفصل الخامس، سأتأمل في أولى الإمبراطوريات العظمى الشرقية والغربية وكيفية ارتفاع تطورهما الاجتماعي مقابل حدود ما كان متاحا في الاقتصادات الزراعية؛ ثم في الفصل السادس سأناقش الانهيار العظيم الذي اجتاح أوراسيا بعد سنة 150 ميلادية تقريبا. وسنصل في الفصل السابع إلى نقطة مفصلية إثر افتتاح المحور الشرقي حدّا رائدا جديدا وتوليه للصدارة في التطور الاجتماعي. مع اقتراب سنة 110 للميلاد، أخذ الشرق يستنزف حدود ما هو ممكن في العالم الزراعي، لكننا سنشهد في الفصل الثامن كيف سيطلق هذا شرارة انهيار ثان عظيم. أما في الفصل التاسع، فسأصف حدود النجاح الجديدة التي أنشأتها الإمبراطوريات الشرقية والغربية على السهوب وعبر المحيطات عند تعافيها من نكساتها، وسأتفحص كيفية سد الغرب فجوة التطور على الشرق. أخيرا، سنرى في الفصل العاشر كيف حوّلت الثورة الصناعية صدارة الغرب وسبقه إلى هيمنة على العالم والمآلات الهائلة التي صاحبتها.
في القسم الثالث (الفصلان الحادي عشر والثاني عشر)، سأوجّه النظر نحو السؤال الأهم الذي يتبادر لذهن أي مؤرخ: ما أهمية كل ذلك وكيف يترابط؟ أولا، في الفصل الحادي عشر، سأربط كل أفكار جدليتي معا من خلال أن ما وراء كل تفاصيل ما حدث طوال الخمسة عشر ألف سنة الماضية، حسمت مجموعتان من القوانين –الخاصتان بالبيولوجيا والسسيولوجيا- أمر شكل التاريخ على النطاق الأوسع، في حين أن المجموعة الثالثة –الخاصة بالجغرافيا- حسمت أمر الاختلافات بين التطور الشرقي والتطور الغربي. فقد كان التأثير المتبادل المستمر بين هذين القانونين، وليس الحتميات بعيدة المدى أو المصادفات قصيرة المدى، هو ما جلب (الكلب) لوتي إلى (قصر) بالمورال بدلا من أن يُؤتى بألبيرت (أسيرا) إلى بكين.
ليس من طبائع المؤرخين تناول أحداث الماضي بهذا الأسلوب. فمعظم العلماء يسعون للبحث عن تفسيرات في الثقافة أو المعتقدات أو القيم والمؤسسات أو الصدفة العمياء بدلا من من استثمار العوامل المتينة للواقع المادي، ويندر أن يكون لهم باع أو ميل نحو التحدث بلغة القوانين. لكن بعد تأمل (ورفض) بعض من هذه البدائل، أرغب بأن أمضي خطوة أخرى إلى الأمام مقترحا في الفصل الثاني عشر أن قوانين التاريخ تمنحنا مفهوما ممتازا يتميز بقدرته على قراءة ما سيتلو من الأحداث المستقبلية. لم يصل التاريخ لنهايته مع الهيمنة الغربية، فنقيض التطور ومزايا التخلف عمليتان ما زالتا تعملان عملهما، ومازال السباق بين الابتكارات التي تقود التطور الاجتماعي نحو الصعود والعراقيل التي تشده نحو الأسفل فعّالتين. وفي الواقع، سأشير إلى أن السباق أصبح محموما أكثر من ذي قبل. وتبشّر الأنواع الجديدة من التطور والعراقيل –أو تنذر- ليس بتحول الجغرافيا فحسب بل البيولوجيا والسسيولوجيا أيضا. إن المسألة الكبرى لعصورنا لا تتوقف عند مدى استمرار الغرب بالهيمنة على العالم، بل تتجاوزها إلى التساؤل ما إذا ستنجح البشرية جمعاء بتحقيق إختراق يكفل إنشاء نوع جديد كليًّا من الوجود قبل أن تقضي علينا كارثة من الكوارث –إلى أبد الدهر.
[/frame]
———————————-



تعليق